النظريات الأساسية للتجارة الدولية. النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية مؤسس النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية
نظريات الميزة النسبية. نظرية الميزة المطلقة. نظرية التجارة العالميةهيكشيرا - أولين. نظرية ليونتيف للتجارة الدولية. نظريات بديلة للتجارة الدولية.
نظريات التجارة الدولية
نظريات الميزة النسبية
التجارة الدولية هي تبادل السلع والخدمات التي تلبي البلدان من خلالها احتياجاتها غير المحدودة على أساس تطوير التقسيم الاجتماعي للعمل.
تم وضع النظريات الرئيسية للتجارة الدولية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. الاقتصاديين البارزين آدم سميث وديفيد ريكاردو. أ. سميث في كتابه "بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الشعوب" (1776) صاغ نظرية الميزة المطلقة ، وجادل المذهب التجاري ، وأظهر أن البلدان مهتمة بالتنمية الحرة للتجارة الدولية ، حيث يمكنها الاستفادة منه بغض النظر عما إذا كانوا مصدرين أو مستوردين. أثبت د.ريكاردو في عمله "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب" (1817) أن مبدأ الميزة ليس سوى حالة خاصة قاعدة عامةوأثبتت نظرية الميزة النسبية.
عند تحليل نظريات التجارة الخارجية ، يجب مراعاة حالتين. أولاً ، الموارد الاقتصادية - المادية ، والطبيعية ، والعمالة ، وما إلى ذلك - موزعة بشكل غير متساو بين البلدان. ثانيًا ، يتطلب الإنتاج الفعال للسلع المختلفة تقنيات مختلفة أو مجموعات من الموارد. من المهم التأكيد ، مع ذلك ، على أن الكفاءة الاقتصادية التي تستطيع البلدان من خلالها إنتاج سلع مختلفة يمكن أن تتغير وتتغير بمرور الوقت. وبعبارة أخرى ، فإن المزايا المطلقة والمقارنة التي تتمتع بها البلدان ليست بيانات إلى الأبد.
نظرية الميزة المطلقة.
إن جوهر نظرية الميزة المطلقة هو كما يلي: إذا كان بإمكان بلد ما أن ينتج هذا المنتج أو ذاك بشكل أكبر وأرخص من البلدان الأخرى ، فإن له ميزة مطلقة.
لنأخذ مثالاً تقليديًا: دولتان ينتجان سلعتين (الحبوب والسكر).
لنفترض أن دولة ما لديها ميزة مطلقة في الحبوب وأخرى في السكر. هذه المزايا المطلقة ، من ناحية ، يمكن أن تولدها العوامل الطبيعية - الظروف المناخية الخاصة أو وجود موارد طبيعية ضخمة. تلعب الفوائد الطبيعية دورًا خاصًا في الزراعة والصناعات الاستخراجية. من ناحية أخرى ، تعتمد مزايا إنتاج المنتجات المختلفة (بشكل أساسي في الصناعات التحويلية) على السائد ظروف العمل: التقنيات ، مؤهلات العمال ، تنظيم الإنتاج ، إلخ.
في الظروف التي لا توجد فيها تجارة خارجية ، يمكن لكل دولة أن تستهلك فقط تلك السلع وكمية تلك السلع التي تنتجها ، ويتم تحديد الأسعار النسبية لهذه السلع في السوق من خلال التكاليف الوطنية لإنتاجها.
الأسعار الداخلية لنفس البضائع في دول مختلفةتختلف دائمًا نتيجة الخصائص المميزة لتوريد عوامل الإنتاج ، والتقنيات المستخدمة ، ومؤهلات القوى العاملة ، إلخ.
لكي تكون التجارة مفيدة للطرفين ، يجب أن يكون سعر أي منتج في السوق الخارجية أعلى من السعر المحلي لنفس المنتج في البلد المصدر وأقل من سعر البلد المستورد.
ستتمثل الفائدة التي تحصل عليها البلدان من التجارة الخارجية في زيادة الاستهلاك ، والتي قد تكون راجعة إلى التخصص في الإنتاج.
لذلك ، وفقًا لنظرية الميزة المطلقة ، يجب أن يتخصص كل بلد في إنتاج المنتج الذي يتمتع بميزة حصرية (مطلقة).
قانون الميزة المقارنة. في عام 1817 ، أثبت د. ريكاردو أن التخصص الدولي مفيد للأمة. كانت هذه نظرية الميزة النسبية ، أو كما يطلق عليها أحيانًا نظرية التكلفة المقارنة للإنتاج. دعونا نفكر في هذه النظرية بمزيد من التفصيل.
أخذ ريكاردو دولتين فقط من أجل البساطة. دعونا نسميهم أمريكا وأوروبا. أيضًا ، لتبسيط الأمور ، أخذ في الاعتبار سلعتين فقط. دعنا نسميهم الطعام والملابس. من أجل التبسيط ، يتم قياس جميع تكاليف الإنتاج في وقت العمل.
ربما ينبغي للمرء أن يتفق على أن التجارة بين أمريكا وأوروبا يجب أن تكون مفيدة للطرفين. يستغرق إنتاج وحدة غذائية في أمريكا أيام عمل أقل من أوروبا ، بينما تستغرق وحدة الملابس في أوروبا أيام عمل أقل من أمريكا. من الواضح أن أمريكا في هذه الحالة ستتخصص على ما يبدو في إنتاج المواد الغذائية ، وفي المقابل ستحصل في المقابل على فستان جاهز تصدّره أوروبا.
ومع ذلك ، لم يتوقف ريكاردو عند هذا الحد. أظهر أن الميزة النسبية تعتمد على نسبة إنتاجية العمل.
بناءً على نظرية الميزة المطلقة ، تظل التجارة الخارجية دائمًا مفيدة لكلا الطرفين. وطالما ظلت الاختلافات في نسب الأسعار المحلية بين البلدان ، فسيكون لكل بلد ميزة نسبية ، أي أنه سيكون لديه دائمًا سلعة يكون إنتاجها أكثر ربحية بالنسبة للنسبة الحالية للتكاليف من إنتاج الآخرين. سيكون الربح من بيع المنتجات أكبر عندما يتم إنتاج كل منتج من قبل الدولة التي تكون فيها تكلفة الفرصة البديلة أقل.
تؤدي مقارنة حالات الميزة المطلقة والميزة النسبية إلى نتيجة مهمة: في كلتا الحالتين ، تنشأ المكاسب من التجارة من حقيقة أن نسب التكلفة مختلفة في البلدان المختلفة ، أي يتم تحديد اتجاهات التجارة من خلال التكاليف النسبية ، بغض النظر عما إذا كانت الدولة لديها ميزة مطلقة في إنتاج منتج أم لا. ويترتب على هذا الاستنتاج أن الدولة تزيد من مكاسبها من التجارة الخارجية إذا كانت متخصصة بالكامل في إنتاج منتج لها ميزة نسبية فيه. في الواقع ، لا يحدث هذا التخصص الكامل ، وهو ما يفسره ، على وجه الخصوص ، حقيقة أن تكاليف الاستبدال تميل إلى الزيادة مع نمو أحجام الإنتاج. في مواجهة زيادة تكاليف الاستبدال ، فإن العوامل التي تحدد اتجاه التجارة هي نفسها مع التكاليف الثابتة (الثابتة). يمكن لكلا البلدين الاستفادة من التجارة الخارجية إذا كانا متخصصين في إنتاج تلك السلع حيث يتمتعان بميزة نسبية. ولكن مع زيادة التكاليف ، أولاً ، فإن التخصص الكامل غير مربح ، وثانيًا ، نتيجة للمنافسة بين البلدان ، يتم تسوية تكاليف الاستبدال الهامشية.
ويترتب على ذلك أنه مع زيادة إنتاج المواد الغذائية والملابس وتخصصها ، سيتم الوصول إلى نقطة يتم فيها تسوية نسبة التكلفة في البلدين.
في هذه الحالة ، فإن أسس تعميق التخصص وتوسيع التجارة - الاختلافات في نسبة التكاليف - تستنفد نفسها ، وسيكون المزيد من التخصص غير مناسب اقتصاديًا.
وبالتالي ، فإن تعظيم المكاسب من التجارة الخارجية يحدث مع التخصص الجزئي.
يتمثل جوهر نظرية الميزة النسبية في ما يلي: إذا تخصصت كل دولة في تلك المنتجات التي تتمتع في إنتاجها بأكبر قدر من الكفاءة النسبية ، أو بتكاليف أقل نسبيًا ، فستكون التجارة مفيدة لكلا البلدين من استخدام المنتج الإنتاجي. ستزداد العوامل في كلتا الحالتين.
يمكن أن يكون لمبدأ الميزة النسبية ، عند توسيع نطاقه ليشمل أي عدد من البلدان وأي عدد من السلع ، آثار عالمية.
عيب خطير في مبدأ الميزة النسبية هو طبيعته الثابتة. تتجاهل هذه النظرية أي تقلبات في الأسعار و أجورفهو يستخلص من أي فجوات تضخمية وانكماشية في المراحل الوسيطة ، من جميع أنواع مشاكل ميزان المدفوعات. ينطلق من افتراض أنه إذا ترك العمال صناعة واحدة ، فلن يتحولوا إلى عاطلين عن العمل بشكل مزمن ، لكنهم سينتقلون بالتأكيد إلى صناعة أخرى أكثر إنتاجية. ليس من المستغرب أن تكون هذه النظرية المجردة قد تعرضت للخطر بشدة خلال فترة الكساد الكبير. منذ بعض الوقت ، بدأت هيبتها تتعافى مرة أخرى. في اقتصاد مختلط ، استنادًا إلى نظرية التوليف الكلاسيكي الجديد ، وتعبئة النظريات الحديثة للركود المزمن والتضخم ، تكتسب النظرية الكلاسيكية للميزة النسبية مرة أخرى أهمية اجتماعية.
نظرية الميزة النسبية هي نظرية متماسكة ومنطقية. على الرغم من كل تبسيطها ، فهي مهمة للغاية. يمكن للأمة التي تتجاهل مبدأ الميزة النسبية أن تدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك - انخفاض في مستويات المعيشة وتباطؤ في النمو الاقتصادي المحتمل.
نظرية هيكشر أولين للتجارة الدولية
تترك نظرية الميزة النسبية جانباً السؤال الرئيسي: ما الذي يسبب اختلافات في التكاليف بين البلدان؟ حاول الاقتصادي السويدي إي. هيكشر وتلميذه ب. أولين الإجابة على هذا السؤال. في رأيهم ، ترجع الاختلافات في التكاليف بين البلدان بشكل أساسي إلى حقيقة أن الهبات النسبية للبلدان ذات عوامل الإنتاج مختلفة.
وفقًا لنظرية Heckscher-Olin ، ستسعى البلدان جاهدة لتصدير عوامل الإنتاج الزائدة واستيراد عوامل الإنتاج النادرة ، وبالتالي تعويض التزويد المنخفض نسبيًا للبلدان بعوامل الإنتاج على نطاق الاقتصاد العالمي.
يجب التأكيد على أننا لا نتحدث عن عدد عوامل الإنتاج المتاحة للبلدان ، ولكن عن التزويد النسبي لها (على سبيل المثال ، حول مساحة الأرض المناسبة للزراعة لكل عامل). إذا كان بعض عامل الإنتاج في بلد معين أكبر نسبيًا منه في البلدان الأخرى ، فسيكون سعره أقل نسبيًا. وبالتالي ، فإن السعر النسبي للمنتج ، الذي يستخدم في إنتاجه هذا العامل الرخيص إلى حد أكبر من غيره ، سيكون أقل "مما هو عليه في البلدان الأخرى. وبالتالي ، تنشأ المزايا النسبية التي تحدد اتجاه التجارة الخارجية.
تشرح نظرية Heckscher-Ohlin بنجاح العديد من الأنماط التي لوحظت في التجارة الدولية. في الواقع ، تصدر البلدان بشكل رئيسي المنتجات التي تهيمن على تكاليفها فائض مواردها نسبيًا. ومع ذلك ، فإن هيكل الموارد الإنتاجية التي تمتلكها البلدان الصناعية تحت تصرفها آخذ في الاستقرار تدريجياً. في السوق العالمية ، تتزايد حصة التجارة في السلع "المتشابهة" بين البلدان "المتشابهة".
نظرية ليونتيف للتجارة الدولية
الاقتصادي الأمريكي الشهير فاسيلي ليونتييف في منتصف الخمسينيات. قام بمحاولة لاختبار الاستنتاجات الرئيسية لنظرية Heckscher-Ohlin تجريبيًا وتوصل إلى استنتاجات متناقضة. باستخدام نموذج المدخلات والمخرجات المبني على أساس البيانات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي لعام 1947 ، أثبت V. تناقضت هذه النتيجة التي تم الحصول عليها تجريبياً مع ما اقترحته نظرية هيكشر-أولين ، وبالتالي سميت "مفارقة ليونتيف". أكدت الدراسات اللاحقة وجود هذا التناقض في فترة ما بعد الحرب ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة ، ولكن أيضًا بالنسبة للبلدان الأخرى (اليابان ، الهند ، إلخ).
جعلت المحاولات العديدة لشرح هذه المفارقة من الممكن تطوير وإثراء نظرية هيكشر-أوهلين من خلال مراعاة الظروف الإضافية التي تؤثر على التخصص الدولي ، ومن بينها ما يلي:
عدم تجانس عوامل الإنتاج ، في المقام الأول العمل ، والتي يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من حيث مستوى المهارة. ومن وجهة النظر هذه ، قد تعكس صادرات البلدان الصناعية فائضًا نسبيًا من العمالة الماهرة والمتخصصين ، بينما تصدر البلدان النامية منتجات تتطلب نفقات كبيرة من العمالة غير الماهرة ؛
سياسة التجارة الخارجية للدولة ، والتي يمكن أن تقيد الواردات وتحفز الإنتاج داخل الدولة وتصدير منتجات تلك الصناعات حيث يتم استخدام عوامل الإنتاج النادرة نسبيًا بشكل مكثف.
نظريات بديلة للتجارة الدولية
في العقود الأخيرة ، حدثت تحولات كبيرة في اتجاهات وهيكل التجارة العالمية ، والتي لا تصلح دائمًا لتفسير شامل في إطار نظريات التجارة الكلاسيكية. هذا يدفع إلى مزيد من التطوير للنظريات الموجودة وتطوير مفاهيم نظرية بديلة. الأسباب هي كما يلي: 1) تحول التقدم التكنولوجي إلى عامل مهيمن في التجارة العالمية ، 2) متزايد باستمرار جاذبية معينةفي تجارة الشحنات المضادة من مماثلة سلع صناعيةيتم إنتاجها في بلدان بها نفس المعروض من عوامل الإنتاج تقريبًا ، و 3) زيادة حادة في حصة حجم التجارة العالمية التي تمثلها التجارة داخل الشركة. ضع في اعتبارك نظريات بديلة.
جوهر نظرية دورة حياة المنتج هو كما يلي: يعتمد تطوير التجارة العالمية في المنتجات النهائية على مراحل حياتها ، أي الفترة الزمنية التي يكون للمنتج خلالها قابلية للتطبيق في السوق ويضمن تحقيق أهداف البائع.
تمتد دورة حياة المنتج إلى أربع مراحل - التبني والنمو والنضج والانحدار. المرحلة الأولى هي التطوير منتجات جديدةاستجابة للحاجة الناشئة داخل البلد. لذلك ، فإن إنتاج منتج جديد يكون ذا طبيعة صغيرة ، ويتطلب عمالًا ذوي مهارات عالية ويتركز في بلد الابتكار (عادة بلد صناعي) ، وتحتل الشركة المصنعة مكانة احتكارية تقريبًا وجزءًا صغيرًا فقط من المنتج يذهب إلى السوق الخارجية.
خلال مرحلة النمو ، يزداد الطلب على المنتج ويتوسع إنتاجه وينتشر تدريجيًا إلى البلدان المتقدمة الأخرى ، ويصبح المنتج أكثر توحيدًا ، وتزداد المنافسة بين الشركات المصنعة وتتوسع الصادرات.
تتميز مرحلة النضج بالإنتاج على نطاق واسع ، ويصبح عامل السعر هو السائد في المنافسة ، ومع توسع الأسواق وانتشار التقنيات ، لم يعد بلد الابتكار يتمتع بمزايا تنافسية. يبدأ التصنيع في الانتقال إلى البلدان النامية حيث يمكن استخدام العمالة الرخيصة بشكل فعال في عمليات التصنيع الموحدة.
مع انخفاض دورة حياة المنتج ، يتناقص الطلب ، خاصة في البلدان المتقدمة ، وتتركز أسواق الإنتاج والمبيعات بشكل أساسي في البلدان النامية ، ويصبح بلد الابتكار مستوردًا متكررًا.
تعكس نظرية دورة حياة المنتج بشكل واقعي إلى حد ما تطور العديد من الصناعات ، ولكنها ليست تفسيرًا عالميًا للاتجاهات في تطوير التجارة الدولية. إذا لم يعد البحث والتطوير ، التكنولوجيا المتقدمة هي العامل الرئيسي الذي يحدد المزايا التنافسية ، فإن إنتاج المنتج سينتقل بالفعل إلى البلدان التي تتمتع بميزة نسبية في عوامل الإنتاج الأخرى ، على سبيل المثال ، من حيث العمالة الرخيصة. ومع ذلك ، هناك العديد من المنتجات (ذات دورة حياة قصيرة ، وتكاليف نقل عالية ، وفرص كبيرة للتمييز في الجودة ، ودائرة ضيقة من المستهلكين المحتملين ، وما إلى ذلك) لا تتناسب مع نظرية دورة الحياة.
اقتصاديات نظرية المقياس. في أوائل الثمانينيات. كروغمان ، ك. لانكستر وبعض الاقتصاديين الآخرين اقترحوا بديلاً للتفسير الكلاسيكي للتجارة الدولية ، بناءً على ما يسمى بتأثير المقياس.
جوهر نظرية التأثير هو أنه مع وجود تقنية معينة وتنظيم الإنتاج ، ينخفض متوسط التكاليف على المدى الطويل مع زيادة حجم الإنتاج ، أي أن هناك اقتصادًا ناتجًا عن الإنتاج الضخم.
وفقًا لهذه النظرية ، يتم تزويد العديد من البلدان (خاصة البلدان الصناعية) بعوامل الإنتاج الرئيسية بنسب مماثلة ، وفي هذه الظروف سيكون من المربح لها التجارة مع بعضها البعض مع التخصص في تلك الصناعات التي تتميز وجود التأثير الإنتاج بكثافة الإنتاج بكميات ضخمة... في هذه الحالة ، يسمح لك التخصص بتوسيع الإنتاج وإنتاج منتج بتكلفة أقل ، وبالتالي بسعر أقل. من أجل تحقيق هذا التأثير للإنتاج الضخم ، يلزم وجود سوق كبير بدرجة كافية. تلعب التجارة الدولية دورًا حاسمًا في هذا ، حيث إنها تسمح بتوسيع أسواق المبيعات. بمعنى آخر ، يسمح بتكوين سوق واحد متكامل ، أكثر رحابة من سوق أي بلد بمفرده. نتيجة لذلك ، يتم تقديم المزيد من المنتجات للمستهلكين وبأسعار أقل.
في الوقت نفسه ، يؤدي تحقيق وفورات الحجم ، كقاعدة عامة ، إلى انتهاك المنافسة الكاملة ، لأنها مرتبطة بتركيز الإنتاج وتوحيد الشركات ، التي أصبحت محتكرة. هيكل الأسواق يتغير تبعا لذلك. تصبح إما احتكار القلة مع هيمنة التجارة بين الصناعات في المنتجات المتجانسة ، أو أسواق المنافسة الاحتكارية مع التجارة داخل الصناعة المتقدمة في المنتجات المتباينة. في هذه الحالة ، تتركز التجارة الدولية بشكل متزايد في أيدي الشركات الدولية العملاقة والشركات عبر الوطنية ، مما يؤدي حتماً إلى زيادة حجم التجارة داخل الشركة ، والتي غالباً ما يتم تحديد اتجاهاتها ليس من خلال مبدأ المزايا النسبية أو الاختلافات في توفير عوامل الإنتاج ، ولكن الأهداف الاستراتيجيةالشركة نفسها.
فهرس
لإعداد هذا العمل تم استخدام مواد من موقع ماتفق.
مركنتيليستنظرية وضعت ونفذت في القرنين السادس عشر والثامن عشر ، هوأول من نظريات التجارة الدولية.
يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن الدولة بحاجة إلى تقييد الواردات ومحاولة إنتاج كل شيء بمفردها ، وكذلك بكل طريقة ممكنة لتشجيع تصدير السلع التامة الصنع ، والسعي إلى تدفق العملة (الذهب) ، أي ، كان التصدير فقط تعتبر مبررة اقتصاديا. نتيجة للميزان التجاري الإيجابي ، أدى تدفق الذهب إلى البلاد إلى زيادة فرص تراكم رأس المال وبالتالي ساهم في النمو الاقتصادي للبلاد والتوظيف والازدهار.
لم يأخذ المذهب التجاري في الاعتبار الفوائد التي تتلقاها البلدان في سياق التقسيم الدولي للعمل من استيراد السلع والخدمات الأجنبية.
وفق النظرية الكلاسيكيةالتجارة العالميةيؤكد أن "التبادل مواتية لـ كل بلد كل بلد يجد فيه ميزة مطلقة "،تم إثبات ضرورة وأهمية التجارة الخارجية.
لأول مرة ، تم تحديد سياسة التجارة الحرة أ. سميث.
ريكاردوطور أفكار أ. سميث وجادل بأنه من مصلحة كل بلد أن يتخصص في الإنتاج الذي تكون فيه المنفعة النسبية أعظم ، وحيث يكون لها أكبر ميزة أو أقل ضعف.
وجد منطق ريكاردو تعبيره في نظرية الميزة النسبية(تكاليف الإنتاج المقارنة). أثبت د. ريكاردو أن التبادل الدولي ممكن ومرغوب فيه لصالح جميع البلدان.
شبيبة مطحنةأوضحت أنه وفقًا لقانون العرض والطلب ، يتم تحديد سعر الصرف عند مستوى يجعل إجمالي الصادرات لكل دولة من الممكن تغطية إجمالي وارداتها.
وفق نظريات هيكشر أوهلينستسعى البلدان دائمًا إلى تصدير عوامل الإنتاج الفائضة سرًا واستيراد عوامل الإنتاج النادرة. أي أن جميع البلدان تميل إلى تصدير السلع التي تتطلب مدخلات كبيرة من عوامل الإنتاج ، والتي تمتلكها بوفرة نسبية. نتيجة ل مفارقة ليونتيف.
المفارقة هي أنه باستخدام نظرية هيكشر-أولين ، أظهر ليونتييف أن الاقتصاد الأمريكي في فترة ما بعد الحرب تخصص في تلك الأنواع من الإنتاج التي تتطلب عمالة أكثر نسبيًا من رأس المال.
نظرية الميزة النسبيةتم تطويره من خلال مراعاة ما يلي الظروف التي تؤثر على التخصص الدولي:
- عدم تجانس عوامل الإنتاج ، وخاصة القوى العاملة ، والاختلاف في مستوى المؤهلات ؛
- دور الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها في الإنتاج فقط بالاقتران مع كميات كبيرة من رأس المال (على سبيل المثال ، في الصناعات الاستخراجية) ؛
- التأثير على التخصص الدولي لسياسات التجارة الخارجية للدول.
كما تعلم ، تمت صياغة أسس نظرية التجارة الدولية في أواخر القرن الثامن عشر - أوائل القرن التاسع عشر. الاقتصاديين الإنجليز البارزين آدم سميث وديفيد ريكاردو.
أ. سميث في كتابه "دراسة حول طبيعة وأسباب ثروة الأمم" (1776) صاغ نظرية الميزة المطلقة ، وجادل مع المذهب التجاري ، وأظهر أن البلدان مهتمة بالتنمية الحرة للتجارة الدولية ، منذ ذلك الحين يمكنهم الاستفادة منه بغض النظر عما إذا كانوا مصدرين أو مستوردين.
نظريات التجارة الدولية
النظريات الحديثة للتجارة الدولية لها تاريخ في السؤال - لماذا تتاجر الدول مع بعضها البعض؟ - وضعه الاقتصاديون بالتزامن مع ظهور أولى مدارس الفكر الاقتصادي في بداية القرن السابع عشر ، والتي بدأت في الاهتمام بتنمية التجارة الخارجية. للنظريات الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة عيبًا واحدًا مهمًا: من أجل تأكيدها عمليًا ، تحتاج إلى تحمل العديد من القيود والافتراضات ، والتي ، للأسف ، يصعب تنفيذها في الحياة الواقعية ، وقد أدى ذلك إلى البحث النشط عن نظريات جديدة تشرح مختلف مشاكل التجارة الخارجية في الظروف الحديثة.
النظرية التجارية للتجارة الدولية
تم إجراء المحاولات الأولى لتحديد معنى التجارة الخارجية ، لصياغة أهدافها في مرحلة انتقال الإقطاع إلى الرأسمالية - القرنين الخامس عشر والثامن عشر. - في العقيدة الاقتصادية لمذهب التجارة (T. Maine ، C. Davenant ، JB Colbert).
التمسك بنظرة ثابتة للعالم ، انطلقوا مما يلي:
ارتبطت ثروة البلاد بالذهب والفضة اللذين تمتلكهما ؛ العالم لديه كمية محدودة من الثروة.
لا يمكن لثروة بلد ما أن تزداد إلا على حساب إفقار دولة أخرى.
تصدير سلع أكثر من الاستيراد ، مما يسمح بزيادة تدفق الذهب والإنتاج والعمالة ؛
تنظيم التجارة الخارجية لزيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال التعريفات والحصص وغيرها من الأدوات ؛
تقييد صارم لتصدير المواد الخام والسماح استيراد معفاة من الرسوم الجمركيةالمواد الخام غير المستخرجة في البلاد ، مما سيسمح بتراكم الذهب والحفاظ على انخفاض أسعار تصدير المنتجات النهائية ؛
لحظر جميع تجارة المستعمرات مع دول أخرى غير العاصمة ، وكذلك إنتاج السلع النهائية.
اعتقد أتباع المذهب التجاري أن الثروة الحقيقية للبلد هي الذهب (المال) ، وبناءً على ذلك ، أنشأوا نظرية التجارة الخارجية. في رأيهم ، يجب أن تركز التجارة الخارجية على أقصى درجات الأمان وزيادة كمية الذهب في البلاد. وفي هذا الصدد ، تمت التوصية بتحفيز الصادرات وتقييد الواردات حتى لا يضيع الذهب في شراء البضائع خارج الدولة. في الوقت نفسه ، تم فرض حظر على تجارة المستعمرات مع جميع البلدان باستثناء المدن الكبرى ، على تطوير الإنتاج في المستعمرات - يجب أن يصبحوا فقط موردي المواد الخام للمدينة.
عرض المذهب التجاري إثراء بعض البلدان على حساب دول أخرى. يجب اعتبار العيب الرئيسي لهذه النظرية هو مفهوم المذهب التجاري ، الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ، وهو أن توفير منفعة بعض المشاركين في صفقة تفاوضية يتضح أنه ضرر اقتصادي للآخرين (البلدان المستوردة). يمكن أن تُعزى الميزة الرئيسية للمذهب التجاري إلى الدعم السياسي للصادرات التي طورتها ، والتي ، جنبًا إلى جنب مع الحمائية النشطة ودعم الاحتكاريين المحليين في روسيا ، ربما كانت أبرز المذهب التجاري - الذي شجع بكل طريقة ممكنة الصناعة الروسية على الموانئ. البضائع ، بما في ذلك من خلال رسوم الاستيراد المرتفعة ، ومجموعة من الامتيازات الاحتكارية المحلية.
كانت المدرسة التجارية قائمة منذ أكثر من قرن ونصف وساهمت في نظرية التجارة الدولية: ولأول مرة ، تم التأكيد على أهمية التجارة الخارجية للنمو الاقتصادي للبلدان ، وتم وصف ميزان المدفوعات. في الوقت نفسه ، كانت آراء المذهب التجاري محدودة من حيث أنهم رأوا إثراء دولة واحدة فقط على حساب إفقار الدولة الأخرى ، وحققوا ذلك بمساعدة السياسات الحمائية.
النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية
تمت صياغة أسس نظرية التجارة الدولية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بواسطة أ. سميث ودي. ريكاردو في إطار المدرسة الكلاسيكية. لأول مرة ، حدد أ. سميث سياسة التجارة الحرة عندما أثبت نظرية التجارة الدولية ، مما يثبت الحاجة إلى تحرير شروط استيراد البضائع الأجنبية من خلال تخفيف القيود الجمركية. جادل أ. سميث بضرورة وأهمية التجارة الخارجية ، مؤكدًا أن "التبادل مناسب لكل بلد ؛ كل بلد يجد فيه ميزة مطلقة". كان تحليل أ. سميث نقطة البداية للنظرية الكلاسيكية ، والتي تعمل كأساس لجميع أنواع سياسة التجارة الحرة.
ريكاردو استكمل وطور أفكار أ. سميث. وأوضح لماذا التجارة بين الدول ، ضمن أي حدود هي الأكثر فائدة التبادل بين البلدين ، وسلط الضوء على معايير التخصص الدولي. يعتقد د. ريكاردو أنه من مصلحة كل بلد أن يتخصص في الإنتاج الذي يتمتع فيه بأكبر ميزة أو أقل ضعف ، والذي يكون فيه المنفعة النسبية أعظم.
نظرية الميزة المطلقة
بدأ الكاتب آدم سميث الفصل الأول من كتابه الشهير "التحقيق في طبيعة وأسباب ثروة الناس" عام 1776 أن "أعظم تقدم في التنمية القوة المنتجةالعمل وحصة كبيرة من الفن والإبداع ".
وبدا أنها موجهة ومرفقة ، كنتيجة لتقسيم العمل وتوصلت إلى استنتاج مفاده أنه إذا كان بإمكان بلد أجنبي أن يمدنا ببعض السلع بسعر أرخص مما نستطيع نحن أنفسنا تصنيعه ، فهو كذلك. أفضل بكثير أن نشتريه منها مقابل بعض منتجات عملنا الصناعي ، المطبق في مجال نتمتع فيه ببعض المزايا.
تنص نظرية المزايا المطلقة على أنه من المستحسن لدولة ما أن تستورد تلك السلع التي تكون تكاليف إنتاجها أعلى من تلك الخاصة بالدول الأجنبية ، وأن تقوم بتصدير السلع التي تكون تكاليف إنتاجها فيها أقل من الخارج ، أي. هناك مزايا مطلقة. على عكس المذهب التجاري ، دعا أ. سميث إلى المنافسة الحرة داخل البلد وفي السوق العالمية ، وشارك في المبدأ الذي طرحته المدرسة الاقتصادية الفرنسية للفيزيوقراطيين. عدم تدخل الدولة في الاقتصاد.
جوهر نظرية الميزة المطلقة - إذا كان بإمكان بلد ما أن ينتج هذا المنتج أو ذاك بشكل أكبر وأرخص من البلدان الأخرى ، فإن له ميزة مطلقة.
الميزة النسبية للتجارة الدولية
وفقًا لنظرية الميزة المطلقة ، يجب أن يتخصص كل بلد في إنتاج المنتج الذي يتمتع بميزة حصرية (مطلقة).
كان عيب نظرية أ. سميث هو أن عوامل الإنتاج لها قدرة مطلقة على التنقل داخل البلد وتنتقل إلى المناطق التي تحصل فيها على أكبر ميزة مطلقة. ولكن بعد فترة ، قد تختفي ميزة بعض المناطق على مناطق أخرى ، وبالتالي ستتوقف التجارة الخارجية أيضًا.
ومع ذلك ، تتمثل مزاياه في حقيقة أنه من خلال وجود المزايا الطبيعية والمكتسبة ، أوضح التدفقات التجارية بين البلدان.
نظرية الميزة النسبية
صاغ د. ريكاردو في عمله "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب" (1817) مبدأ أكثر عمومية للتجارة المتبادلة والتخصص الدولي ، بما في ذلك كحالة خاصة نموذج أ. سميث. وأوضح أن التجارة الدولية تعود بالفائدة على كل دولة ، حتى لو لم يكن لأي منها ميزة مطلقة في إنتاج سلع معينة. صاغ د. ريكاردو نظرية الميزة النسبية ، مقدمًا مفهوم السعر البديل. السعر البديل هو نسبة وقت العمل المطلوب لإنتاج وحدة من سلعة واحدة إلى وقت العمل المطلوب لإنتاج وحدة من سلعة أخرى. يمكن صياغة قانون الميزة النسبية على النحو التالي: تتخصص البلدان في إنتاج تلك السلع التي تكون تكاليف العمالة فيها أقل نسبيًا ، على الرغم من أنها قد تكون أعلى إلى حد ما من الخارج. أدى ذلك إلى الاستنتاج: تؤدي التجارة العالمية الحرة إلى التخصص في إنتاج كل بلد ، وتطوير إنتاج السلع ذات الفائدة النسبية ، وزيادة الإنتاج في جميع أنحاء العالم ، وكذلك إلى زيادة الاستهلاك في كل بلد.
كان لنظرية المزايا النسبية بعض العيوب التي ساهمت بشكل أكبر في ذبولها. بينهم:
تستند النظرية على وجود دولتين فقط وسلعتين ؛
يعني هيمنة التجارة الحرة ؛
عائدات تكاليف الإنتاج الثابتة ؛
يفترض عدم وجود تكاليف النقل ؛
لا يأخذ في الاعتبار عمل الثورة العلمية والتكنولوجية ، والتغيرات التقنية ؛
عائدات من وجود قابلية كاملة للتبادل للموارد في استخدامها البديل.
- · وصف ميزان العرض والطلب الإجمالي لأول مرة.
- · ثبت أن البلاد تحصل على فوائد من التجارة الخارجية ، دون الإضرار بالدول الأخرى ، ولكن من خلال البحث عن فرص لتطوير التجارة داخل البلاد ورفض فرض الحواجز التجارية.
- · قدم أساسًا علميًا لتطوير المزيد من النظريات.
نظرية هيكشر - أولين - صامويلسون
في أواخر القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين. نتيجة للتحولات الهيكلية في التجارة العالمية ، انخفض دور الاختلافات الطبيعية كعامل في التصوير بالرنين المغناطيسي.
ابتكر E. Heckscher و B. Olin (20-30 عامًا من القرن العشرين) نظرية تشرح أسباب التجارة الدولية في تصنيع المنتجات.
تتمتع البلدان بدرجات متفاوتة من العمالة ورأس المال والأرض وكذلك الاحتياجات المختلفة لبعض السلع. في بلد تتوافر فيه موارد العمالة وفيرة ورأس المال غير كافٍ ، ستكون العمالة رخيصة نسبيًا ورأس المال باهظ الثمن ، والعكس صحيح. وبالتالي ، يمكن صياغة نظرية Heckscher-Ohlin على النحو التالي: تصدر كل دولة تلك السلع التي لديها عوامل إنتاج فائضة نسبيًا لإنتاجها ، وتستورد تلك السلع التي تعاني من نقص نسبي في عوامل الإنتاج لإنتاجها. وفقًا لنموذج Heckscher-Ohlin:
تستند التجارة على الميزات النسبية للبلدان ؛
سبب الميزة النسبية هو الاختلاف في موهبة البلدان بعوامل الإنتاج.
في منتصف القرن العشرين. قام الاقتصاديان الأمريكيان L. Samuelson و W. Stolper بتحسين نظرية Heckscher-Ohlin من خلال تقديم أنه في حالة تجانس عوامل الإنتاج والتكنولوجيا المتطابقة والمنافسة الكاملة والتنقل الكامل للسلع ، فإن التجارة الدولية تعادل سعر عوامل الإنتاج بين البلدان . يعتمد المفهوم على نموذج د. ريكاردو مع إضافات هيكشر وأولين ويعتبر التجارة العالمية ليس فقط بمثابة تبادل متبادل المنفعة ، ولكن أيضًا كوسيلة لتضييق الفجوة في مستوى التنمية بين البلدان.
نظرية ليونتيف للتجارة الدولية
وجد الاقتصادي الأمريكي من أصل روسي في.ليونتيف ، الذي درس هيكل الصادرات والواردات الأمريكية في عام 1956 ، أنه على عكس نظرية هيكشر-أوهلين ، سادت السلع كثيفة العمالة نسبيًا في الصادرات الأمريكية ، والسلع كثيفة رأس المال في الواردات .
أصبحت هذه النتيجة معروفة باسم مفارقة ليونتيف.
أظهر المزيد من البحث أن التناقض الذي اكتشفه V. Leontiev يمكن إزالته إذا تم أخذ أكثر من عاملين للإنتاج في الاعتبار عند تحليل هيكل التجارة.
بعد تضمينه في التحليل أكثر من عاملين للإنتاج ، بما في ذلك STP ، والاختلافات في أنواع العمالة (المهرة وغير المهرة) والأجور المتمايزة في البلدان المختلفة ، أوضح V. Leontyev التناقض أعلاه وبالتالي ساهم في نظرية المزايا النسبية.
النظرية التكنولوجية الجديدة للتجارة الخارجية
يتمثل الجانب الضعيف من النظريات الكلاسيكية في أنه من أجل تأكيدها العملي ، من الضروري الامتثال للعديد من القيود والافتراضات. لذلك ، اقتصاديو القرن العشرين. البحث عن نظريات جديدة تشرح مختلف جوانب التجارة الدولية ، بناءً على النظريات الكلاسيكية ، وتطويرها أو دحضها.
تشغيل المرحلة الحاليةتتعايش المدرسة الكلاسيكية الجديدة مع المدرسة التكنولوجية الجديدة ، التي تطورت منذ منتصف القرن العشرين. على أساس ثورة علمية وتكنولوجية. نظريات التجارة الدولية التي ظهرت على أساس الثورة العلمية والتكنولوجية رفضت تمامًا المفاهيم الأساسية للنظريات الكلاسيكية وقدمت مناهج أخرى لشرح التجارة العالمية. ميزات مدرسة التكنولوجيا الحديثة للتجارة الدولية:
إدراج عوامل ومتغيرات جديدة إضافية في عملية البحث ، بما في ذلك الموارد البشرية والرأسمالية المختلفة للبلدان ، والتقدم العلمي والتقني ، وظروف السوق غير الكاملة للسلع وعوامل الإنتاج والتنقل الدولي للأخيرة ، وما إلى ذلك ؛
تم استكمال نهج الاقتصاد الكلي لتحليل التجارة العالمية بمقاربة الاقتصاد الجزئي ، وارتبطت المزايا الرئيسية بموقف احتكار الشركة (البلد) - المبتكر ؛
كان موضوع التجارة الدولية في هذه الحالة هو التكنولوجيا - سواء المتجسدة في سلع عالية التقنية أو في شكل تراخيص ؛
تربط مدرسة التكنولوجيا الجديدة المزايا الرئيسية بالمكانة الاحتكارية للشركة المبتكرة (الدولة). ومن هنا جاءت الاستراتيجية الجديدة للشركات الفردية: ألا تنتج ما هو أرخص نسبيًا ، ولكن ما هو ضروري للجميع أو للكثيرين ، ولكن ما لا يستطيع أي شخص آخر إنتاجه حتى الآن ؛
يمكن للدولة وينبغي لها أن تدعم إنتاج سلع تصديرية عالية التقنية وألا تتدخل في تقليص إنتاج سلع أخرى عفا عليها الزمن.
تشمل التقنيات الحديثة ما يلي:
نظرية الفجوة التكنولوجية M. Posner (1961)؛
نظرية اقتصاديات الحجم بواسطة S. Camp (1964) ؛
نظرية المنافسة غير الكاملة P. Krugman (1979)؛
نظرية دورة حياة البضائع بواسطة R. Vernon (1966) ؛
نظرية م. بورتر للميزة التنافسية للأمة (1986) وغيرها.
نظرية فجوة التكنولوجيا
نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي ، تحدث الابتكارات في إحدى الصناعات في البداية في دولة رائدة أو أكثر. لفترة معينة من الزمن ، احتلت هذه البلدان مكانة احتكارية في العالم في إنتاج منتج جديد. وبالتالي ، فإن الميزة التي يكتسبها بلد مبتكر هي نتيجة الفجوة التكنولوجية التي نشأت في مستويات التنمية في البلدان الفردية.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث تغييرات في تخصص التجارة الخارجية للبلاد ، مما يشجعها على التخلي جزئيًا عن إنتاج المنتجات التقليدية ، التي تتمتع فيها بمزايا نسبية ، والتحول إلى إنتاج منتجات أصلية ليس لها نظائر في العالم.
اقتصاديات نظرية المقياس
مع بعض التقنيات وتنظيم الإنتاج ، ينخفض متوسط التكاليف على المدى الطويل مع زيادة حجم الإنتاج ، أي تنشأ اقتصاديات الحجم من الإنتاج الضخم. ووفقًا للنظرية ، فإن العديد من الدول (خاصة المتقدمة منها) يتم تزويدها بعوامل الإنتاج الرئيسية بنسب متشابهة ، وفي هذه الظروف سيكون من المربح لها التجارة مع بعضها البعض مع التخصص في تلك الصناعات التي تتميز بوجودها. لتأثير الإنتاج الضخم. من أجل تحقيق تأثير الإنتاج الضخم ، هناك حاجة إلى سوق كبير. تلعب التجارة الدولية دورًا حاسمًا في توسيع أسواق المبيعات. يسمح بتكوين سوق واحد متكامل ، أكثر رحابة من سوق بلد واحد. نتيجة لذلك ، يتم تقديم المزيد من المنتجات للمستهلكين وبأسعار أقل.
نظرية دورة حياة المنتج
تم تطوير النظرية في النصف الثاني من الستينيات بواسطة R. فيرنون ، سي.كيندلبرج ول. ويلز. وفقًا للمفهوم ، منتج جديديمر بدورة حياة ذات مراحل: التنفيذ والتوسع والنضج والشيخوخة ، والتي على أساسها يمكن تفسير العلاقات التجارية الحديثة بين البلدان في تبادل المنتجات النهائية.
وفقًا لدورة الحياة ، تتخصص البلدان في إنتاج صادرات من نفس السلعة في مراحل مختلفة من النضج.
نظرية م. بورتر للميزة التنافسية للأمة
الفكرة الرئيسية: on السوق الدوليتتنافس الشركات ، وليس البلدان ، لذلك من المهم أن نفهم كيف تخلق الشركة الميزة التنافسية وتحافظ عليها ، وفهم دور الدولة في هذه العملية. تتحدد القدرة التنافسية لأي بلد في التجارة الدولية من خلال تأثير وترابط أربعة مكونات رئيسية تسمى "الماس التنافسي". يتم تحديد القدرة التنافسية لأي بلد في التبادل الدولي من خلال التفاعل والترابط بين المكونات الرئيسية (محددات الميزة التنافسية):
شروط العامل - عوامل الإنتاج المحددة اللازمة للمنافسة الناجحة في صناعة معينة ؛
شروط الطلب على السلع والخدمات ، أي ما هو الطلب في السوق المحلي على المنتجات والخدمات التي تقدمها الصناعة ؛
استراتيجية الشركات في بلد معين ، هيكلها والتنافس ، أي ما هي الظروف في الدولة التي تحدد كيفية إنشاء الشركات وإدارتها ، وما هي طبيعة المنافسة في السوق المحلية ؛
طبيعة الصناعات ذات الصلة والداعمة المتوفرة في الدولة - وجود أو غياب في البلد للصناعات ذات الصلة أو الداعمة المنافسة في السوق العالمية.
نظرية الشركة
ترتبط النظرية بالدور المتزايد للشركات والمؤسسات الفردية في التجارة الدولية. لا يتم تلقي المزايا دائمًا من قبل الدولة ، ولكن من قبل شركة فردية - مصدر المنتج المحدد. فقط بعد توسيع الإنتاج وتشبع السوق المحلية يمكن للشركة دخول السوق الخارجية. لبيع منتجاتك ، تحتاج إلى العثور على بلد مشترٍ ، يكون هيكله للطلب في السوق المحلية أقرب ما يمكن إلى هيكل الطلب في البلد المصدر. وهذا يجعل من الممكن إجراء المعاملات التجارية بين البلدان التي هي على نفس مستوى التنمية الاقتصادية ، وبين البلدان الصناعية المتقدمة. تم إثبات هذا الحكم لأول مرة من قبل الاقتصادي الأمريكي إي. ليندر. بعد ذلك ، أثبت مؤيدو نظرية الشركة الحاجة إلى دمج الشركات في البلدان المتقدمة مع الشركات في الدول الصناعية الفتية. كان هذا بسبب التقارب بين مستويات التطور العلمي والتقني ، وتعزيز اتصالات الإنتاج والمبيعات ، والحل المشترك للمشاكل العلمية والتقنية. وقد احتضنت هذه العملية الصناعات كثيفة المعرفة. الدور الأكثر نشاطا في ذلك كان من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
مركنتيليستنظرية وضعت ونفذت في القرنين السادس عشر والثامن عشر ، هوأول من نظريات التجارة الدولية.
يعتقد مؤيدو هذه النظرية أن الدولة بحاجة إلى تقييد الواردات ومحاولة إنتاج كل شيء بمفردها ، وكذلك بكل طريقة ممكنة لتشجيع تصدير السلع التامة الصنع ، والسعي إلى تدفق العملة (الذهب) ، أي ، كان التصدير فقط تعتبر مبررة اقتصاديا. نتيجة للميزان التجاري الإيجابي ، أدى تدفق الذهب إلى البلاد إلى زيادة فرص تراكم رأس المال وبالتالي ساهم في النمو الاقتصادي للبلاد والتوظيف والازدهار.
لم يأخذ المذهب التجاري في الاعتبار الفوائد التي تتلقاها البلدان في سياق التقسيم الدولي للعمل من استيراد السلع والخدمات الأجنبية.
وفقًا للنظرية الكلاسيكية للتجارة الدوليةيؤكد أن "التبادل مواتية لـ كل بلد كل بلد يجد فيه ميزة مطلقة "،تم إثبات ضرورة وأهمية التجارة الخارجية.
لأول مرة ، تم تحديد سياسة التجارة الحرة أ. سميث.
ريكاردوطور أفكار أ. سميث وجادل بأنه من مصلحة كل بلد أن يتخصص في الإنتاج الذي تكون فيه المنفعة النسبية أعظم ، وحيث يكون لها أكبر ميزة أو أقل ضعف.
وجد منطق ريكاردو تعبيره في نظرية الميزة النسبية(تكاليف الإنتاج المقارنة). أثبت د. ريكاردو أن التبادل الدولي ممكن ومرغوب فيه لصالح جميع البلدان.
شبيبة مطحنةأوضحت أنه وفقًا لقانون العرض والطلب ، يتم تحديد سعر الصرف عند مستوى يجعل إجمالي الصادرات لكل دولة من الممكن تغطية إجمالي وارداتها.
وفق نظريات هيكشر أوهلينستسعى البلدان دائمًا إلى تصدير عوامل الإنتاج الفائضة سرًا واستيراد عوامل الإنتاج النادرة. أي أن جميع البلدان تميل إلى تصدير السلع التي تتطلب مدخلات كبيرة من عوامل الإنتاج ، والتي تمتلكها بوفرة نسبية. نتيجة ل مفارقة ليونتيف.
المفارقة هي أنه باستخدام نظرية هيكشر-أولين ، أظهر ليونتييف أن الاقتصاد الأمريكي في فترة ما بعد الحرب تخصص في تلك الأنواع من الإنتاج التي تتطلب عمالة أكثر نسبيًا من رأس المال.
نظرية الميزة النسبيةتم تطويره من خلال مراعاة ما يلي الظروف التي تؤثر على التخصص الدولي:
- عدم تجانس عوامل الإنتاج ، وخاصة القوى العاملة ، والاختلاف في مستوى المؤهلات ؛
- دور الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها في الإنتاج فقط بالاقتران مع كميات كبيرة من رأس المال (على سبيل المثال ، في الصناعات الاستخراجية) ؛
- التأثير على التخصص الدولي لسياسات التجارة الخارجية للدول.
يمكن للدولة تقييد الواردات وتحفيز الإنتاج داخل الدولة وتصدير منتجات تلك الصناعات حيث يتم استخدامها بشكل مكثف نسبيًا عوامل الإنتاج النادرة.
نظرية مايكل بورتر للميزة التنافسية
في عام 1991 ، نشر الخبير الاقتصادي الأمريكي مايكل بورتر دراسة بعنوان "المزايا التنافسية للبلدان" التي نُشرت باللغة الروسية بعنوان "المنافسة الدولية" في عام 1993. في هذه الدراسة ، تم وضع نهج جديد تمامًا لمشاكل التجارة الدولية بتفاصيل كافية. أحد الشروط الأساسية لهذا النهج هو ما يلي: الشركات ، وليس البلدان ، تتنافس في السوق الدولية. لفهم دور الدولة في هذه العملية ، من الضروري فهم كيفية قيام شركة فردية بإنشاء ميزة تنافسية والحفاظ عليها.
يعتمد النجاح في السوق الخارجية على استراتيجية تنافسية تم اختيارها بشكل صحيح. تنطوي المنافسة على تغييرات مستمرة في الصناعة ، مما يؤثر بشكل كبير على المعايير الاجتماعية والاقتصاد الكلي للبلد الأم دورا مهماتلعب الدولة في هذه العملية.
وفقًا لـ M ، Porter ، فإن الوحدة الرئيسية للمنافسة هي الصناعة ، أي مجموعة من المنافسين ينتجون السلع ويقدمون الخدمات ويتنافسون بشكل مباشر مع بعضهم البعض. تنتج الصناعة منتجات ذات مصادر مماثلة للميزة التنافسية ، على الرغم من أن الحدود بين الصناعات تكون دائمًا غامضة إلى حد ما. لإختيار الإستراتيجية التنافسية للشركةهناك نوعان من العوامل الرئيسية في الصناعة.
1. هياكل الصناعة ،التي تعمل فيها الشركة ، أي ميزات المنافسة. تتأثر المنافسة في الصناعة بخمسة عوامل:
1) ظهور منافسين جدد ؛
2) ظهور سلع أو خدمات بديلة ؛
3) قدرة الموردين على المساومة.
4) قدرة المشترين على المساومة ؛
5) التنافس بين المنافسين الحاليين فيما بينهم.
تحدد هذه العوامل الخمسة ربحية الصناعة لأنها تؤثر على معدلات الرغوة التي تحددها الشركات وتكاليفها ونفقاتها الرأسمالية وغير ذلك.
مع دخول منافسين جدد إلى الصناعة ، تتضاءل إمكانات الربحية الإجمالية للصناعة لأنها تجلب قدرة تصنيعية جديدة إلى الصناعة وتسعى للحصول على حصة في السوق ، ومع ظهور منتجات أو خدمات بديلة ، يكون السعر الذي يمكن أن تفرضه الشركة مقابل منتجها محدودًا.
الموردين والمشترين ، عند المساومة ، يستمدون فوائدهم ، مما قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة -
السعر الذي يجب دفعه مقابل القدرة التنافسية عند التنافس مع الشركات الأخرى هو إما تكاليف إضافية أو انخفاض في السعر ، ونتيجة لذلك ، انخفاض في الأرباح.
يتم تحديد أهمية كل من العوامل الخمسة من خلال التقنية الرئيسية و الخصائص الاقتصادية... على سبيل المثال ، تعتمد قدرة المشترين على المساومة على عدد المشترين لدى الشركة ، وكمية المبيعات التي تقع على مشتر واحد ، وما إذا كان سعر المنتج جزءًا مهمًا من إجمالي تكاليف المشتري ، وتهديد المنافسين الجدد حول مدى صعوبة "اختراق" الصناعة. ...
2. المكانة التي تحتلها الشركة في الصناعة.
يتم تحديد مكانة الشركة في الصناعة بشكل أساسي بواسطة ميزة تنافسية.تتقدم الشركة على منافسيها إذا كانت تتمتع بميزة تنافسية مستقرة:
1) انخفاض التكاليف ، مما يشير إلى قدرة الشركة على تطوير وإنتاج وبيع منتج مماثل بتكلفة أقل من المنافسين. بيع منتج بنفس سعر المنافسين أو بنفس سعره تقريبًا ، تحقق الشركة في هذه الحالة ربحًا كبيرًا.
2) مفاضلة البضائع ، أي قدرة الشركة على تلبية احتياجات المشتري ، وتقديم سلع إما بجودة أعلى ، أو بخصائص استهلاكية خاصة ، أو مع فرص واسعة لخدمة ما بعد البيع.
تمنحك الميزة التنافسية إنتاجية أعلى من المنافسة. عامل مهم آخر يؤثر على مكانة الشركة في الصناعة هو نطاق المنافسة ، أو نطاق الغرض الذي تستهدفه الشركة داخل صناعتها.
المنافسة لا تعني التوازن ، بل التغيير المستمر. يتم تحسين وتحديث كل صناعة باستمرار. علاوة على ذلك ، يلعب الوطن دورًا مهمًا في تحفيز هذه العملية. الوطن -إنها دولة يتم فيها تطوير الإستراتيجيات والمنتجات الأساسية والتكنولوجيا وتوفر قوة عاملة بالمهارات اللازمة.
يحدد م. بورتر أربع خصائص لدولة ما تشكل البيئة التي تتنافس فيها الشركات المحلية والتي تؤثر على نجاحها الدولي (الشكل 4.6). يمكن تمثيل النموذج الديناميكي لتشكيل المزايا التنافسية للصناعة في شكل ماسة وطنية.
الشكل 4.6.محددات الميزة التنافسية للدولة
من المرجح أن تنجح البلدان في الصناعات التي تعزز فيها مكونات الماس الوطني بعضها البعض.
هذه المحددات ، كل على حدة وكلها معًا كنظام ، تخلق البيئة التي تولد وتعمل فيها الشركات في بلد معين.
تحقق البلدان نجاحًا في بعض الصناعات نظرًا لحقيقة أن البيئة في هذه البلدان تتطور بشكل ديناميكي وتتحدى الشركات باستمرار المهام الصعبة، تجعلهم يستخدمون مزاياهم التنافسية الحالية بشكل أفضل.
الميزة على كل محدد ليست شرطا مسبقا للميزة التنافسية في الصناعة. إن تفاعل المزايا عبر جميع المحددات هو الذي يوفر نقاط فوز ذاتية التعزيز غير متوفرة للمنافسين الأجانب.
يمتلك كل بلد ، بدرجة أو بأخرى ، عوامل الإنتاج اللازمة لأنشطة الشركات في أي صناعة. تكرس نظرية الميزة النسبية في نموذج Heckscher-Ohlin لمقارنة العوامل المتاحة. تقوم الدولة بتصدير البضائع ، حيث يتم استخدام عوامل مختلفة بشكل مكثف في إنتاجها. ومع ذلك ، العوامل. كقاعدة عامة ، لا يتم توريثها فحسب ، بل يتم إنشاؤها أيضًا ، لذلك ، للحصول على المزايا التنافسية وتطويرها ، ليس مخزون العوامل في الوقت الحالي هو المهم ، ولكن سرعة إنشائها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لوفرة العوامل أن تقوض الميزة التنافسية ، وعدم وجودها يمكن أن يؤدي إلى التجديد ، مما قد يؤدي إلى ميزة تنافسية طويلة الأجل. في الوقت نفسه ، يعتبر الهبة بالعوامل أمرًا مهمًا للغاية ، وبالتالي فهذه هي المعلمة الأولى لهذا المكون من "الماس".
الهبة بالعوامل
تقليديا ، تميّز الأدبيات الاقتصادية ثلاثة عوامل: العمل والأرض ورأس المال. لكن تأثيرهم ينعكس الآن بشكل كامل في تصنيف مختلف قليلاً:
· الموارد البشرية ، وتتميز بعدد العمالة ومؤهلاتها وتكلفتها ومدة ساعات العمل العادية وأخلاقيات العمل.
تنقسم هذه الموارد إلى فئات عديدة ، حيث تتطلب كل صناعة قائمة محددة من فئات محددة من العمال ؛
· الموارد المادية ، والتي يتم تحديدها من خلال كمية ونوعية وتوافر وتكلفة الأرض والمياه والمعادن والموارد الحرجية ومصادر الكهرباء ، إلخ. ويمكن أن تشمل هذه أيضًا الظروف المناخية والموقع الجغرافي وحتى المنطقة الزمنية ؛
مصدر المعرفة ، أي مجموعة من المعلومات العلمية والتقنية والتجارية التي تؤثر على السلع والخدمات. يتركز هذا المخزون في الجامعات والمؤسسات البحثية وبنوك البيانات والأدب وما إلى ذلك ؛
· الموارد النقدية ، وتتسم بحجم وقيمة رأس المال الذي يمكن استخدامه لتمويل الصناعة.
البنية التحتية ، بما في ذلك نظام النقل ، ونظام الاتصالات ، والخدمات البريدية ، وتحويل المدفوعات بين البنوك ، ونظام الرعاية الصحية ، إلخ.
تختلف مجموعة العوامل المطبقة من صناعة إلى أخرى ، حيث تحقق الشركات ميزة تنافسية عندما يكون لديها عوامل رخيصة أو عالية الجودة تحت تصرفها والتي تعتبر مهمة في المنافسة في صناعة معينة. وبالتالي ، فإن موقع سنغافورة على طريق تجاري مهم بين اليابان والشرق الأوسط جعلها مركزًا لصناعة إصلاح السفن. ومع ذلك ، فإن الحصول على ميزة تنافسية بناءً على عوامل لا يعتمد كثيرًا على توافرها بقدر ما يعتمد على استخدامها الفعال ، نظرًا لأن الشركات متعددة الجنسيات يمكن أن توفر العوامل المفقودة عن طريق شراء أو تحديد موقع الأنشطة في الخارج ، كما أن العديد من العوامل تنتقل ببساطة نسبيًا من بلد إلى بلد.
تنقسم العوامل إلى عوامل أساسية ومتطورة وعامة ومتخصصة. تشمل العوامل الرئيسية الموارد الطبيعية ، والظروف المناخية ، والموقع الجغرافي ، والعمالة غير الماهرة ، وما إلى ذلك ، والتي يتم تلقيها من قبل الدولة من خلال الميراث أو بقليل من الاستثمار. فهي قليلة الأهمية للميزة التنافسية للدولة ، أو أن الميزة التي تخلقها غير مستدامة. يتناقص دور العوامل الرئيسية بسبب انخفاض الحاجة إليها أو بسبب زيادة توافرها (بما في ذلك نتيجة نقل الأنشطة أو المشتريات إلى الخارج). هذه العوامل مهمة في الصناعات الاستخراجية و الخامسالصناعات المتعلقة بالزراعة. تشمل العوامل المتطورة البنية التحتية الحديثة ، والقوى العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا ، وما إلى ذلك.
نظريات التجارة الدولية
هذه هي العوامل الأكثر أهمية ، لأنها تسمح لك بتحقيق مستوى أعلى من الميزة التنافسية.
حسب درجة التخصص ، تنقسم العوامل إلى عوامل عامة يمكن تطبيقها في كثير من الصناعات ، ومتخصصة. تشكل العوامل المتخصصة أساسًا أكثر صلابة واستمرارية للميزة التنافسية من العوامل العامة.
يجب مراعاة معايير تقسيم العوامل إلى عوامل أساسية ومتطورة وعامة ومتخصصة في الديناميكيات ، لأنها تتغير بمرور الوقت ، وتختلف العوامل اعتمادًا على ما إذا كانت قد نشأت بطريقة ليونية أو تم إنشاؤها بشكل مصطنع. جميع العوامل التي تساهم في تحقيق مستوى أعلى من الميزة التنافسية مصطنعة. تنجح البلدان في الصناعات التي تكون فيها أفضل قدرة على إنشاء العوامل الضرورية وتحسينها.
شروط الطلب (معلمات)
المحدد الثاني للميزة التنافسية الوطنية هو الطلب في السوق المحلية على السلع أو الخدمات التي تقدمها هذه الصناعة. التأثير على اقتصاديات الحجم ، والطلب في السوق المحلية يحدد طبيعة وسرعة الابتكار. يتميز بـ: هيكل النمو وحجمه وطبيعته ، التدويل.
يمكن للشركات تحقيق ميزة تنافسية بالنظر إلى الخصائص الرئيسية التالية لهيكل الطلب:
· يقع جزء كبير من الطلب المحلي على قطاعات السوق العالمية.
· المشترون (بما في ذلك الوسطاء) انتقائيون ومتطلبون ، مما يجبر الشركات على رفع معايير جودة تصنيع المنتجات والخدمات وخصائص المستهلك للسلع ؛
· تنشأ الحاجة في الوطن في وقت أبكر مما هي عليه في البلدان الأخرى ؛
· حجم وطبيعة النمو في الطلب المحلي يسمحان للشركات باكتساب ميزة تنافسية إذا كان هناك طلب في الخارج على منتج مطلوب بشدة في السوق المحلية ، وهناك أيضًا عدد كبير من المشترين المستقلين ، مما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للتجديد ؛
· يتزايد الطلب المحلي بسرعة ، مما يحفز على تكثيف الاستثمار الرأسمالي وسرعة التجديد.
· يتشبع السوق الداخلي بسرعة ، ونتيجة لذلك ، تصبح المنافسة أكثر صرامة ، حيث يبقى الأقوى على قيد الحياة ، مما يجبرهم على دخول السوق الخارجية.
يعتمد تأثير معايير الطلب على القدرة التنافسية أيضًا على أجزاء أخرى من الماس. وبالتالي ، بدون منافسة قوية ، لا يؤدي وجود سوق محلي واسع أو نموه السريع إلى تحفيز الاستثمار دائمًا. بدون دعم الصناعات ذات الصلة ، لن تتمكن الشركات من تلبية احتياجات المشترين المميزين ، وما إلى ذلك.
الصناعات ذات الصلة والداعمة
المحدد الثالث الذي يحدد الميزة التنافسية الوطنية هو التواجد في الدولة لتوريد الصناعات أو الصناعات ذات الصلة والمنافسة في السوق العالمية ،
في ظل وجود صناعات الموردين التنافسية ، يكون ما يلي ممكنًا:
· الوصول الفعال والسريع إلى الموارد الباهظة الثمن ، مثل المعدات أو العمالة الماهرة ، وما إلى ذلك ؛
· التنسيق بين الموردين في السوق المحلي.
· مساعدة عملية الابتكار. تستفيد الشركات المحلية أكثر عندما يكون مورديها قادرين على المنافسة في السوق العالمية.
غالبًا ما يؤدي وجود الصناعات ذات الصلة التنافسية في البلد إلى ظهور أنواع إنتاج جديدة عالية التطور. متعلق بيشير إلى الصناعات التي يمكن أن تتفاعل فيها الشركات مع بعضها البعض لتشكيل سلسلة قيمة ، وكذلك الصناعات التي تتعامل مع المنتجات التكميلية مثل أجهزة الكمبيوتر والبرامج. يمكن أن يحدث التفاعل في مجال تطوير التكنولوجيا والإنتاج والتسويق والخدمة. إذا كان لدى بلد ما صناعات ذات صلة يمكنها التنافس في السوق العالمية ، فإن الوصول إلى تبادل المعلومات والتفاعل التقني يفتح. يؤدي القرب الجغرافي والتقارب الثقافي إلى تبادل أكثر نشاطًا من الشركات الأجنبية.
قد يؤدي النجاح في سوق Myronian لصناعة واحدة إلى تطوير الإنتاج بضائع إضافيةوالخدمات. ومع ذلك ، فإن نجاح التوريد والصناعات ذات الصلة يمكن أن يؤثر فقط على نجاح الشركات الوطنية إذا تأثرت بقية الماس بشكل إيجابي.
محاضرات عن دورة "الاقتصاد العالمي".FROLOVA T.A.
الموضوع 1: نظرية التجارة الدولية 2
1. نظرية الميزة النسبية 2
2. النظريات الكلاسيكية الجديدة 3
3. نظرية هيكشر - أولين 3
4. مفارقة ليونتيف 4
5. نظريات بديلة للتجارة الدولية 4
الموضوع 2. السوق العالمي 6
1. جوهر الاقتصاد العالمي 6
2. مراحل تكوين الاقتصاد العالمي 6
3. هيكل السوق العالمية 7
4. المنافسة في السوق العالمية 8
5. تنظيم الدولة للتجارة العالمية 9
الموضوع 3. نظام المال العالمي 10
1. مراحل تطور النظام النقدي العالمي 10
2. أسعار الصرف وقابلية تحويل العملات 12
3. تنظيم الدولة لسعر الصرف .14
4. ميزان المدفوعات 15
الموضوع 4: التكامل الاقتصادي الدولي 17
1. أشكال التكامل الاقتصادي 17
2. أشكال حركة رأس المال 17
3. الآثار المترتبة على تصدير واستيراد رأس المال 18
4. هجرة اليد العاملة 20
5. تنظيم الدولة لهجرة اليد العاملة 21
الموضوع 5. عولمة ومشاكل الاقتصاد العالمي 22
1 العولمة: الكيان والتحديات التي يخلقها 22
3. المنظمات الاقتصادية الدولية 23
موضوع 6. المناطق الاقتصادية الخاصة 25
1- تصنيف المنطقة الحرة 25
3. فوائد ومراحل دورة حياة المنطقة الاقتصادية الخاصة 26
الموضوع 1: نظرية التجارة الدولية
1. نظرية الميزة النسبية
مرت نظرية التجارة الدولية بعدة مراحل في تطورها إلى جانب تطور الفكر الاقتصادي. ومع ذلك ، كانت أسئلتهم الرئيسية ولا تزال كما يلي: ما الذي يكمن في صميم التقسيم الدولي للعمل؟ ما هو التخصص الدولي الأكثر فاعلية للدول؟
تم وضع أسس نظرية التجارة الدولية في أواخر القرن الثامن عشر - أوائل القرن التاسع عشر. الاقتصاديين الإنجليز آدم سميث وديفيد ريكاردو. أظهر سميث في عمله "بحث عن طبيعة وأسباب ثروات الشعوب" أن الدول مهتمة بالتنمية الحرة للتجارة الدولية ، لأن يمكن الاستفادة منه سواء كانوا مصدرين أو مستوردين. لقد ابتكر نظرية الميزة المطلقة.
أثبت ريكاردو في عمله "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب" أن مبدأ الميزة المطلقة ليس سوى حالة خاصة من القاعدة العامة ، وأثبت نظرية الميزة النسبية.
تتمتع الدولة بميزة مطلقة إذا كانت هناك سلعة يمكنها ، لكل وحدة تكلفة ، إنتاج أكثر من بلد آخر.
هذه المزايا ، من ناحية ، يمكن أن تولدها العوامل الطبيعية - الظروف المناخية الخاصة ، وتوافر الموارد الطبيعية. تلعب الفوائد الطبيعية دورًا خاصًا في الزراعة والصناعات الاستخراجية.
من ناحية أخرى ، يمكن الحصول على الفوائد ، أي بسبب تطور التكنولوجيا ، وتحسين مؤهلات العمال ، وتحسين تنظيم الإنتاج.
في حالة عدم وجود تجارة خارجية ، يمكن لكل دولة أن تستهلك فقط تلك السلع والكمية التي تنتجها فقط.
يتم تحديد الأسعار النسبية للسلع في السوق المحلية من خلال التكاليف النسبية لإنتاجها. تختلف الأسعار النسبية لنفس المنتج المنتج في بلدان مختلفة. إذا تجاوز هذا الاختلاف تكلفة نقل البضائع ، فهناك فرصة للربح من التجارة الخارجية.
لكي تكون التجارة مفيدة للطرفين ، يجب أن يكون سعر المنتج في السوق الخارجية أعلى من السعر المحلي في البلد المصدر وأقل منه في البلد المستورد.
النظريات الأساسية للتجارة الدولية
تتمثل الفائدة التي تحصل عليها البلدان من التجارة الخارجية في زيادة الاستهلاك ، والتي قد ترجع إلى سببين:
التغييرات في أنماط الاستهلاك ؛
تخصص الإنتاج.
طالما لا تزال هناك اختلافات في نسب الأسعار المحلية بين البلدان ، فإن كل بلد سيكون كذلك الميزة النسبية، بمعنى آخر. سيكون لديها دائمًا سلعة ، يكون إنتاجها أكثر ربحية بالنسبة للنسبة الحالية للتكاليف من إنتاج الآخرين.
سيكون الحجم الإجمالي للإنتاج أكبر عندما يتم إنتاج كل منتج من قبل الدولة التي تكون فيها تكاليف الفرصة البديلة أقل. يتم تحديد اتجاهات التجارة العالمية من خلال التكاليف النسبية.
2. النظريات الكلاسيكية الجديدة
طور الاقتصاديون الغربيون المعاصرون نظرية ريكاردو للتكاليف المقارنة. الأكثر شهرة هو نموذج تكلفة الفرصة ، ومؤلفه الاقتصادي الأمريكي ج. هابرلر.
يتم النظر في نموذج اقتصاد دولتين ، حيث يتم إنتاج سلعتين. تم افتراض منحنيات لكل بلد قدرات الإنتاج... يتم استخدام أفضل التقنيات وجميع الموارد. عند تحديد الميزة النسبية لكل دولة ، يكون الأساس هو حجم إنتاج سلعة واحدة ، والتي يجب تخفيضها من أجل زيادة إنتاج سلعة أخرى.
يسمى هذا النموذج لتقسيم العمل بالنموذج الكلاسيكي الجديد. لكنها تقوم على عدد من التبسيط. يأتي من وجود:
دولتان فقط و منتجان ؛
تجارة حرة
حركة اليد العاملة داخل البلد وعدم القدرة على الحركة (لا تجاوز) من قبل البلدان ؛
تكاليف الإنتاج الثابتة
نقص تكاليف النقل
لا توجد تغييرات فنية
إمكانية التبادل الكامل للموارد في استخدامها البديل.
3. نظرية هيكشر-أولين
في الثلاثينيات. ابتكر الاقتصاديان السويديان في القرن العشرين إيلي هيكشر وبرتيل أولين نموذجهما الخاص للتجارة الدولية. بحلول هذا الوقت ، حدثت تغييرات كبيرة في نظام التقسيم الدولي للعمل والتجارة الدولية. وقد تضاءل دور الاختلافات الطبيعية كعامل من عوامل التخصص الدولي بشكل ملحوظ ، وبدأت السلع الصناعية تسود في صادرات الدول المتقدمة. يهدف نموذج Heckscher-Ohlin إلى شرح أسباب التجارة الدولية في السلع المصنعة.
في إنتاج السلع المختلفة ، يتم استخدام العوامل بنسب مختلفة ؛
إن الهبات النسبية للبلدان ذات عوامل الإنتاج ليست هي نفسها.
ومن ثم يتبع قانون تناسب العوامل: في الاقتصاد المفتوح ، يميل كل بلد إلى التخصص في إنتاج سلعة تتطلب المزيد من العوامل ، والتي تتمتع بها البلاد بشكل أفضل نسبيًا.
التبادل الدولي هو تبادل العوامل الوفيرة مقابل العوامل النادرة.
وبالتالي ، يتم تصدير عوامل الفائض بشكل خفي ويتم استيراد عوامل الإنتاج النادرة ، أي تعوض حركة البضائع من بلد إلى بلد عن الحركة المنخفضة لعوامل الإنتاج على نطاق الاقتصاد العالمي.
في عملية التجارة الدولية ، يتم معادلة أسعار عوامل الإنتاج. في البداية ، سيكون سعر العامل الزائد منخفضًا نسبيًا. يؤدي فائض رأس المال إلى التخصص في إنتاج السلع كثيفة رأس المال ، وتدفق رأس المال إلى صناعات التصدير. وبالتالي فإن الطلب على رأس المال يزيد من سعر رأس المال.
إذا كانت هناك وفرة من العمالة في البلاد ، فسيتم تصدير السلع كثيفة العمالة. كما يرتفع سعر العمالة (الأجور).
4. مفارقة ليونتيف
درس فاسيلي ليونيف في برلين بعد تخرجه من جامعة لينينغراد. في عام 1931 هاجر إلى الولايات المتحدة وبدأ التدريس في جامعة هارفارد. منذ عام 1948 عين مديرا للخدمة البحث الاقتصادي... تطوير طريقة التحليل الاقتصادي "المدخلات والمخرجات" (تستخدم للتنبؤ). في عام 1973 حصل على جائزة نوبل.
في عام 1947 ، حاول ليونتييف اختبار استنتاجات نظرية هيكشر-أوهلين تجريبياً وتوصل إلى استنتاجات متناقضة. عند فحص هيكل الصادرات والواردات الأمريكية ، وجد أن السلع كثيفة العمالة نسبيًا هي السائدة في الصادرات الأمريكية ، والسلع كثيفة رأس المال هي السائدة في الواردات.
بالنظر إلى أنه في سنوات ما بعد الحرب في الولايات المتحدة كان رأس المال عامل فائض نسبيًا للإنتاج ، وكان مستوى الأجور أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى ، فإن هذه النتيجة تتعارض مع نظرية هيكشر-أولين ، وبالتالي سميت بمفارقة ليونتيف.
افترض ليونتييف أنه في أي مزيج مع مبلغ معين من رأس المال ، فإن سنة واحدة من العمل الأمريكي تعادل 3 سنوات من العمل الأجنبي. وأشار إلى أن زيادة الإنتاجية في العمالة الأمريكية ترتبط بمستويات مهارات أعلى لدى العمال الأمريكيين. أجرى ليونيف اختبارًا إحصائيًا أظهر أن الولايات المتحدة تصدر سلعًا تتطلب عمالة ماهرة أكثر من تلك المستوردة.
استُخدمت هذه الدراسة كأساس لإنشاء الاقتصادي الأمريكي د. كيسينج في عام 1956 ، وهو نموذج يأخذ في الاعتبار مؤهلات القوى العاملة. هناك ثلاثة عوامل تدخل في الإنتاج: رأس المال والعمالة الماهرة وغير الماهرة. تؤدي الوفرة النسبية للعمالة عالية المهارة إلى تصدير السلع التي تتطلب كميات كبيرة من العمالة الماهرة.
استخدمت النماذج اللاحقة من الاقتصاديين الغربيين 5 عوامل: رأس المال المالي، والعمالة الماهرة وغير الماهرة ، والأراضي المناسبة للإنتاج الزراعي ، والموارد الطبيعية الأخرى.
5. نظريات بديلة للتجارة الدولية
في العقود الأخيرة من القرن العشرين ، حدثت تحولات كبيرة في اتجاهات وهيكل التجارة الدولية ، والتي لم يتم تفسيرها دائمًا من خلال نظرية الترجمة الآلية الكلاسيكية. من بين هذه التحولات النوعية ، ينبغي للمرء أن يلاحظ تحول التقدم العلمي والتكنولوجي إلى عامل مهيمن في التجارة الدولية ، ونسبة متزايدة من عمليات التسليم العكسي للسلع الصناعية المماثلة. أصبح من الضروري أخذ هذا التأثير في الاعتبار في نظريات التجارة الدولية.
نظرية دورة حياة المنتج.
في منتصف الستينيات. طرح الاقتصادي الأمريكي في القرن العشرين R. Vernon نظرية دورة حياة المنتج ، حيث حاول شرح تطور التجارة العالمية في المنتجات النهائية على أساس مراحل حياتها.
مرحلة الحياة هي الفترة الزمنية التي يكون فيها للمنتج قابلية للتطبيق في السوق وتضمن تحقيق أهداف البائع.
تغطي دورة حياة المنتج 4 مراحل:
تطبيق. في هذه المرحلة ، يتم تطوير منتج جديد استجابة للحاجة الناشئة داخل الدولة. الإنتاج ذو طبيعة صغيرة ، ويتطلب عمالا ذوي مهارات عالية ويتركز في بلد الابتكار. الشركة المصنعة لديها موقف احتكار تقريبا. يذهب جزء صغير فقط من المنتج إلى السوق الخارجية.
ارتفاع. يتزايد الطلب على المنتج ، ويتوسع إنتاجه وينتشر إلى البلدان المتقدمة الأخرى. أصبح المنتج موحدًا. المنافسة تتزايد والصادرات آخذة في التوسع.
نضج. تتميز هذه المرحلة بالإنتاج على نطاق واسع ؛ يسود عامل السعر في المنافسة. لم يعد بلد الابتكار يتمتع بأي مزايا تنافسية. يبدأ الإنتاج في الانتقال إلى البلدان النامية حيث العمالة أرخص.
يتناقص. في البلدان المتقدمة ، الإنتاج آخذ في الانخفاض ، وتتركز أسواق المبيعات في البلدان النامية. يصبح بلد الابتكار مستورداً صافياً.
اقتصاديات نظرية المقياس.
في أوائل الثمانينيات. القرن العشرين اقترح P. Krugman و K. لانكستر تفسيرا بديلا للتجارة الدولية ، على أساس اقتصاديات الحجم. جوهر التأثير هو أنه مع وجود تقنية معينة وتنظيم الإنتاج ، ينخفض متوسط التكاليف على المدى الطويل مع زيادة حجم الإنتاج ، أي تنشأ اقتصاديات الحجم من الإنتاج الضخم.
ووفقًا لهذه النظرية ، يتم تزويد العديد من الدول بعوامل الإنتاج الرئيسية بنسب متشابهة ، وبالتالي سيكون من المربح لها التجارة مع بعضها البعض بالتخصص في الصناعات التي تتميز بوجود تأثير الإنتاج الضخم. يسمح لك التخصص بتوسيع أحجام الإنتاج وتقليل التكاليف والأسعار. من أجل تحقيق وفورات الحجم ، يلزم وجود سوق كبير ، أي العالمية.
نموذج الفجوة التكنولوجية.
حاول أنصار الاتجاه التكنولوجي الحديث شرح هيكل التجارة الدولية بالعوامل التكنولوجية. ترتبط المزايا الرئيسية بالموقف الاحتكاري للشركة المبتكرة. استراتيجية مثالية جديدة للشركات: ألا تنتج ما هو أرخص نسبيًا ، ولكن ما يحتاجه الجميع ، ولكن لا يستطيع أحد إنتاجه بعد. بمجرد أن يتمكن الآخرون من إتقان هذه التكنولوجيا - لإنتاج شيء جديد.
كما تغير الموقف من الدولة. وفقًا لنموذج Heckscher-Ohlin ، تتمثل مهمة الحكومة في عدم التدخل في الشركات. يعتقد الاقتصاديون في مجال التكنولوجيا الجديدة أن الدولة يجب أن تدعم إنتاج سلع تصديرية عالية التقنية وألا تتدخل في تقليص الصناعات التي عفا عليها الزمن.
النموذج الأكثر شيوعًا هو نموذج فجوة التكنولوجيا. تم وضع أسسها في عام 1961 في عمل الاقتصادي الإنجليزي م. بوسنر. في وقت لاحق ، تم تطوير النموذج في أعمال R.Vernon ، R. Findlay ، E.Mansfield.
يمكن أن تحدث التجارة بين البلدان بسبب التغيرات التكنولوجية التي تحدث في أي صناعة واحدة في أحد البلدان التجارية. تكتسب الدولة ميزة نسبية: التكنولوجيا الجديدة تجعل من الممكن إنتاج سلع بتكلفة منخفضة. إذا تم إنشاء منتج جديد ، فإن الشركة المبتكرة لديها شبه احتكار لفترة زمنية معينة ، أي يحصل على ربح إضافي.
نتيجة للابتكارات التقنية ، فجوة تكنولوجيةبين الدول. سيتم سد هذه الفجوة بشكل تدريجي ستبدأ الدول الأخرى في نسخ ابتكار البلد المبتكر. لشرح بوسنر التجارة الدولية القائمة باستمرار ، يقدم مفهوم "تيار الابتكار" ، والذي ظهر بمرور الوقت في صناعات مختلفة وبلدان مختلفة.
كلا البلدين التجاريين يستفيدان من الابتكار. مع انتشار التكنولوجيا الجديدة ، تستمر الدولة الأقل تقدمًا في المكاسب وتفقد البلدان الأكثر تقدمًا مزاياها. وبالتالي ، توجد التجارة الدولية حتى عندما تتمتع البلدان على قدم المساواة بعوامل الإنتاج.
الصفحات: التالي →
123456 انظر الكل
نظرياتدوليتجارة (7)
ملخص >> علم الاقتصاد
... الموارد الطبيعية الأخرى. ( محاضرات Leontyeva V.E.) جوهر التمويل ... المجالات ، مثل نظريةدوليتجارة, نظريةالاحتكار والاقتصاد القياسي. موقف L. ... آخذ في الازدياد في عصرنا. عصريالاقتصاد ، الذي يمثل ...
نظرياتدوليتجارة (4)
ملخص >> علم الاقتصاد
... هذا السؤال في وقت سابق " محاضرات "، كانت هذه الحجج هي التي دفعت الكلاسيكيات ... جزء من الكلاسيكيات نظريةدوليتجارةومعظمها عصريتفسيرات تشرح معنى الخارجي تجارة، منافع اقتصادية ...
الرئيسية نظريةدوليتجارة (4)
مجردة >> النظرية الاقتصادية
... أولين ، نظريةم. بورتر ومفارقة ف. ليونتييف. موضوع الدراسة - دوليتجارة... الخامس عصريالظروف ... في عام 1748. بدأ القراءة العامة محاضراتفي الأدب والقانون الطبيعي ... في نفس العام في محاضراتفي عدد من اقتصادياتهم الرئيسية ...
أساسيات دوليتجارة (2)
الدورات الدراسية >> النظرية الاقتصادية
.. وعلى الصعيد العملي. أساسيات عصرينظريةدوليتجارةتم وضعها في القرن التاسع عشر. كلاسيكيات اللغة الإنجليزية ... Yablokova، S.А. الاقتصاد العالمي [نص]: خلاصة محاضرات/ س. يابلوكوفا. - م: قبل ذلك ، 2007. - 160 ص. - رقم ال ISBN ...
الرئيسية نظريةدوليتجارة (2)
دليل الدراسة >> الاقتصاد
... إي يو. دوليتجارة: حسنا محاضرات. – … دوليتجارة... موضوع البحث هو نظريةدوليتجارة. نظريةدوليتجارةهيكشر أولين. نظريةالميزة النسبية توضح الاتجاهات دوليتجارة …
أريد المزيد من الأعمال المماثلة ...
النظريات الحديثة للاقتصاد العالمي
⇐ السابق الصفحة 3 من 7 التالي ⇒
اقتصاديات نظرية المقياس لكروجمان ولانكسترتم إنشاؤه في الثمانينيات من القرن العشرين. تقدم هذه النظرية تفسيرًا للأسباب الحديثة للتجارة العالمية من حيث اقتصاد الشركة. يعتقد المؤلفون أن أقصى فائدة تكمن في الصناعات التي يتم فيها الإنتاج على دفعات كبيرة ، لأن في هذه الحالة هناك تأثير مقياس.
تعود أصول نظرية اقتصاديات الحجم إلى أ. مارشال ، الذي لاحظ الأسباب الرئيسية لمزايا مجموعة من الشركات على شركة فردية. قدم كل من M. Camp و P. Krugman أكبر مساهمة في النظرية الحديثة لاقتصاديات الحجم. تشرح هذه النظرية سبب وجود تجارة بين البلدان التي تتمتع بنفس القدر بعوامل الإنتاج. يتفق منتجو هذه البلدان فيما بينهم على أن بلدًا ما يتلقى كلاً من سوقه الخاص وسوق أحد الجيران من أجل التجارة الحرة في أي منتج معين ، ولكن في المقابل يمنح بلدًا آخر شريحة سوقية لمنتج آخر. ومن ثم يحصل المنتجون في كلا البلدين على أسواق لأنفسهم تتمتع بقدرة أكبر على امتصاص البضائع. وعملائهم سلع أرخص. لأنه مع نمو أحجام السوق ، تبدأ وفورات الحجم في العمل ، والتي تبدو كما يلي: مع زيادة حجم الإنتاج ، تنخفض تكلفة إنتاج كل وحدة من وحدات الإنتاج.
لماذا ا؟ لأن تكاليف الإنتاج لا تنمو بالمعدل الذي تنمو به أحجام الإنتاج. السبب هو كما يلي. ذلك الجزء من التكاليف ، الذي يسمى "ثابت" ، لا ينمو على الإطلاق ، وهذا الجزء الذي يسمى "متغير" ينمو بمعدل أقل من حجم الإنتاج. لأن المكون الرئيسي في تكاليف الإنتاج المتغيرة هو تكلفة المواد الخام. وعند شرائه بكميات أكبر ، ينخفض سعر وحدة السلع. كما تعلم ، كلما زاد سعر البيع بالجملة ، كان سعر الشراء أكثر ملاءمة.
يتم تزويد العديد من البلدان بعوامل الإنتاج الرئيسية بنسب مماثلة ، وبالتالي سيكون من المربح لها التجارة مع بعضها البعض مع التخصص في الصناعات التي تتميز بوجود تأثير الإنتاج الضخم. يسمح لك التخصص بتوسيع أحجام الإنتاج وتقليل التكاليف والأسعار.
من أجل تحقيق وفورات الحجم ، يلزم وجود أكبر سوق ممكن ، أي العالمية. ثم يتبين أنه من أجل زيادة حجم أسواقها ، تتفق البلدان ذات القدرات المتساوية على عدم التنافس على نفس المنتجات في نفس الأسواق [مما يؤدي بالمنتجين إلى انخفاض الدخل]. على العكس من ذلك ، لتوسيع فرص مبيعاتهم لبعضهم البعض ، وتوفير الوصول المجاني إلى أسواقهم لشركات البلدان الشريكة ، من خلال تخصيص كل بلد على السلع "الخاصة".
يصبح من المربح للبلدان أن تتخصص وتتبادل حتى المنتجات المتجانسة من الناحية التكنولوجية ولكن المتباينة (ما يسمى بالتجارة داخل الصناعة).
![]() فورسيشتلوحظ تأثير المقياس حتى حد معين للنمو بهذا المقياس بالذات. في وقت ما ، تصبح تكاليف الإدارة المتزايدة تدريجياً باهظة و "تلتهم" ربحية الشركة من الزيادة في حجمها. لأن المزيد والمزيد الشركات الكبيرةتزداد صعوبة السيطرة عليها.
فورسيشتلوحظ تأثير المقياس حتى حد معين للنمو بهذا المقياس بالذات. في وقت ما ، تصبح تكاليف الإدارة المتزايدة تدريجياً باهظة و "تلتهم" ربحية الشركة من الزيادة في حجمها. لأن المزيد والمزيد الشركات الكبيرةتزداد صعوبة السيطرة عليها.
نظرية دورة حياة المنتج.ظهرت هذه النظرية عند تطبيقها لشرح تخصص البلدان في الاقتصاد العالمي في الستينيات من القرن العشرين. مؤلف هذه النظرية ، فيرنون ،شرح التجارة العالمية من حيث التسويق.
الحقيقة هي أن المنتج في عملية وجوده في السوق يمر بعدة مراحل: الإنشاء والنضج وتدهور الإنتاج واختفاءه. وفقًا لهذه النظرية ، تتخصص الدول الصناعية في إنتاج سلع جديدة تقنيًا ، والدول النامية - في إنتاج سلع متقادمة ، حيث يتطلب إنشاء سلع جديدة رأس مال كبير ومتخصصين مؤهلين تأهيلاً عالياً وعلمًا متطورًا في هذا المجال. كل هذا متوفر في البلدان الصناعية.
وفقًا لملاحظات فيرنون ، في مراحل الإنشاء والنمو والنضج ، يتركز إنتاج السلع في البلدان الصناعية ، منذ ذلك الحين خلال هذه الفترة ، يعطي المنتج أقصى ربح. ولكن بمرور الوقت ، يصبح المنتج متقادمًا ويدخل في مرحلة "الانحدار" أو الاستقرار. يتم تسهيل ذلك من خلال حقيقة ظهور البضائع - منافسي الشركات الأخرى ، مما يؤدي إلى تشتيت انتباه الطلب. نتيجة لكل هذا ، انخفض السعر والأرباح.
يتم الآن نقل إنتاج السلع المتقادمة إلى البلدان الفقيرة ، حيث سيصبح ، أولاً ، منتجًا جديدًا ، وثانيًا ، سيكون إنتاجه في هذه البلدان أرخص. في نفس المرحلة من تقادم المنتج ، يجوز للشركة بيع ترخيص لتصنيع منتجها إلى بلد نام.
إن نظرية دورة حياة المنتج ليست تفسيرًا شاملاً لاتجاهات تطور التجارة الدولية. هناك العديد من المنتجات ذات دورة الحياة القصيرة ، وتكاليف النقل المرتفعة ، ودائرة ضيقة من المستهلكين المحتملين ، وما إلى ذلك ، والتي لا تتناسب مع نظرية دورة الحياة.
ولكن الأهم من ذلك ، أن الشركات العالمية ظلت لفترة طويلة تحدد موقع إنتاج كل من السلع المبتكرة والسلع المتقادمة في نفس البلدان النامية.
التجارة العالمية
شيء آخر هو أنه في حين أن المنتج جديد ومكلف ، إلا أنه يباع بشكل أساسي في البلدان الغنية ، وعندما يصبح عتيقًا ، ينتقل إلى الدول الفقيرة. وفي هذا الجزء من نظريته ، لا يزال فيرنون ذا صلة.
نظرية م. بورتر للمزايا التنافسية.هناك نظرية مهمة أخرى تشرح تخصص البلدان في الاقتصاد العالمي نظرية م. بورتر للمزايا التنافسية... في ذلك ، يفحص المؤلف تخصص البلدان في التجارة العالمية من وجهة نظر مزاياها التنافسية. وفقًا لـ M. Porter ، لتحقيق النجاح في السوق العالمية ، من الضروري الجمع بين الاستراتيجية التنافسية المختارة بشكل صحيح للشركات مع المزايا التنافسية للبلد.
يسلط الضوء على بورتر أربع علامات على الميزة التنافسية:
⇐ السابق 1234567 التالي ⇒
© 2015 arhivinfo.ru جميع الحقوق مملوكة لمؤلفي المواد المنشورة.
2.2.1. المذهب التجاري.ظهرت النظرية التجارية للتجارة الدولية أثناء تطور التجارة العالمية في القرنين السادس عشر والثامن عشر. وعبروا عن مصالح التجار. يمكن صياغة الأحكام الرئيسية للنظرية على النحو التالي:
1) النقود (الذهب والفضة) - الشكل المطلق للثروة ؛
2) موضوع البحث هو مجال التداول.
3) يحدث تراكم الثروة في شكل نقدي على حساب أرباح التجارة الخارجية أو استخراج المعادن الثمينة ؛
4) التدخل الحكومي في الاقتصاد ضروري من خلال تنظيم التجارة الخارجية.
في تطورها ، مرت المذهب التجاري بمرحلتين. عارض المذهب التجاري الأوائل ، مؤيدو الميزان النقدي ، تصدير الذهب والفضة من البلاد. سمح المذهب التجاري الراحل ، المؤيدون لنظام الميزان التجاري ، بتصدير المعادن الثمينة إذا تم تحقيق توازن إيجابي في التجارة بشكل عام. ودعوا إلى المعالجة الصناعية للمواد الخام والاستفادة من فوائد التجارة العابرة. تعكس آراء المذهب التجاري الراحل بالفعل ليس مصالح التاجر فحسب ، بل أيضًا مصالح رأس المال الصناعي.
العيب الرئيسي لنظرية المذهب التجاري هو ، من وجهة نظرهم ، أن المنفعة الاقتصادية لبعض المشاركين في صفقة تجارية - البلدان المصدرة - تبين أنها أضرار اقتصادية للآخرين - البلدان المستوردة. الميزة الرئيسية هي سياسة دعم الصادرات التي طورتها ، جنبًا إلى جنب مع سياسة الحماية النشطة للدولة.
2.2.2 النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية.النظرية الكلاسيكية الأساسية للتجارة الدولية هي نظرية المزايا المطلقة لألف سميث.إنه ينطلق من أماكن معاكسة للمذهب التجاري. أ. سميث يفحص اقتصاد المنافسة الحرة ، حيث تقوم "اليد الخفية" للسوق بتنسيق أعمال العديد من المنتجين بحيث يضمن كل من الوكلاء الاقتصاديين ، الذين يسعون لتحقيق مصلحتهم الخاصة ، رفاهية المجتمع ككل. تبريرًا لسياسة عدم تدخل الدولة في الاقتصاد والمنافسة الحرة (سياسة "عدم التدخل") ، دعا أ. سميث إلى التجارة الحرة. صياغة المتطلبات الأساسية نماذج سميثعلى النحو التالي:
· المنافسة الكاملة في جميع الأسواق.
· يتم النظر في دولتين تختلفان فقط في تكنولوجيا الإنتاج.
· في كلا البلدين يتم إنتاج سلعتين ، ويتم تحليل اقتصاد المقايضة ، ولا يوجد نقود.
· هناك عامل واحد للإنتاج - العمل ، إنه متجانس ويمكنه التنقل بحرية بين الصناعات ، لكنه لا يستطيع التنقل بين البلدان ؛
· يحلل اقتصاد العمالة الكاملة.
· تكاليف النقل تساوي الصفر.
· التجارة الخارجية حرة.
تتمتع الدولة بميزة مطلقة إذا كان بإمكانها إنتاج منتج بتكلفة أقل من بلد آخر (أو بإنتاجية أعلى). رسميًا ، ينعكس ذلك على النحو التالي: تتمتع الدولة الأولى بميزة مطلقة في إنتاج السلعة الأولى إذا
أين - الوقت اللازم لإنتاج وحدة من السلع يفي البلاد أنا;
أين كمية البضائع المنتجة يلكل وحدة زمنية في البلد أنا(إنتاجية العمالة في الدولة أنا).
بناء على ما سبق، نظرية سميثتمت صياغته على النحو التالي: بالنسبة للتصدير ، يجب توجيه تلك البضائع ، التي تقل تكاليف إنتاجها عنها في البلدان الأخرى ، وبالتالي البضائع المستوردة ، التي تقل تكاليف إنتاجها في الخارج تمامًا عن تكلفة الإنتاج في الوطن.
وهكذا ، وفقًا لنظرية أ. سميث ، فإن تطوير الإنتاج الوطني على أساس الميزة المطلقة في التجارة الحرة يسمح لكل دولة بالاستفادة في الوقت نفسه من التجارة الدولية ، وبيع البضائع بالأسعار العالمية.
عيب النظرية أنها تترك الأجوبة مفتوحة لعدد من الأسئلة التي تنشأ في سياق العلاقات التجارية الخارجية: ماذا يحدث إذا لم يكن للبلد ميزة مطلقة في إنتاج أي منتج؟ هل سيكون مثل هذا البلد قادرًا على أن يكون شريكًا كاملاً في التجارة الخارجية؟ هل ستوافق الدول الأخرى على التجارة معها؟ أليس هذا البلد محكوما عليه بضرورة شراء كل البضائع التي يحتاجها في السوق العالمية؟ كيف ، إذن ، ستكون قادرة على دفع ثمن البضائع المشتراة في الخارج؟ يمكنك العثور على إجابات لهذه الأسئلة في نظرية المزايا النسبية (النسبية) لد. ريكاردو.تتشابه مبادئ هذه النظرية مع تلك الخاصة بنظرية سميث. يقدم د. ريكاردو مفهوم المزايا النسبية (المقارنة).
في تحديد المزايا المطلقة، يقارن تكاليف الوحدة لنفس المنتج في بلدان مختلفة. في تحديد المزايا النسبية، أولاً ، تتم مقارنة المنتجات مع بعضها البعض ، ثم التكاليف النسبية لمنتج واحد في بلدان مختلفة. لو
إذن فالدولة الأولى لها ميزة نسبية في إنتاج السلعة الأولى. في التفسير الحديث (G. Heberler) ، هذا يعني أن تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلعة الأولى في الدولة الأولى أقل من الثانية.
نظرية ريكاردويبدو مثل هذا: إذا تخصصت البلدان في إنتاج تلك السلع التي يمكن أن تنتجها بتكاليف أقل نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى ، فإن التجارة ستكون مفيدة للطرفين لكلا البلدين. تستفيد البلدان ذات الإنتاجية العالية والمنخفضة الإنتاجية من التجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن في نماذج ريكاردوتكلفة الفرصة البديلة ثابتة. تشير ثبات التكاليف إلى أن الدولة ستكسب أكبر قدر إذا تخصصت بالكامل في منتج له ميزة نسبية في إنتاجه. في سعر ثابتلن تتمكن إحدى البلدين التجاريين من التخصص الكامل في الصادرات إلا إذا كان السعر العالمي يطابق نسبة السعر المحلي في غياب التجارة. في هذه الحالة ، الدولة التي تتغير فيها نسبة السعر هي دولة كبيرة ، والثانية دولة صغيرة. تستمر البلدان الكبيرة في إنتاج كلتا السلعتين في التجارة الحرة لأن البلدان الصغيرة لا تستطيع تصدير سلع كافية لتلبية الطلب على هذه السلع في بلد كبير.
تشمل عيوب النموذج ما يلي:
1) ثبات تكاليف الفرصة البديلة في النموذج ؛
2) يسمح قانون الميزة النسبية بالتخصص الكامل للدول في إنتاج سلع معينة ، وهو ما لا يحدث في الواقع ؛
3) نموذج د. ريكاردو لا يأخذ في الحسبان الاختلاف في منح البلدان الفردية موارد الإنتاج ؛
4) تستخلص نظرية الميزة النسبية من تأثير التجارة الدولية على توزيع الدخل داخل الدولة ، وهذا هو الحال في الواقع ؛
5) على أساس النموذج الريكاردي ، من المستحيل تفسير تبادل التدفقات الكبيرة من السلع المتشابهة بين البلدان نفسها التي لا تتمتع بمزايا نسبية فيما يتعلق ببعضها البعض ؛
6) اتباع وصفات نظرية المزايا النسبية يعني بالنسبة للدول النامية الحفاظ على الفقر الدائم والتخلف.
2.2.3. النظريات الكلاسيكية الجديدة للتجارة الدولية.نظرية نسبة عوامل الإنتاج (Heckscher-Ohlin)يشرح سبب ظهور المزايا النسبية. تجادل نظرية هيكشر-أولين بأن الهبة النسبية غير المتكافئة للبلدان ذات الموارد الإنتاجية تخلق اختلافًا في الأسعار النسبية للسلع ، والتي بدورها تخلق الشروط المسبقة لظهور وتنمية التجارة الدولية. يمكن تمثيل هذه النظرية في شكل نظريتين مترابطتين: الأولى ، ما يسمى نظريات هيكشر-أولين الذي يشرح هيكل التجارة الدولية وثانيًا ، نظرية معادلة سعر العامل ، أو نظرية هيكشر-أوهلين-صامويلسون ، والتي تتناول تأثير التجارة الدولية على أسعار عوامل الإنتاج.
تتضمن متطلبات النموذج الأحكام التالية:
1) المنافسة الكاملة في جميع الأسواق ؛
2) اعتبار دولتين وسلعتين ، اقتصاد المقايضة ؛
3) تحليل عاملين للإنتاج - العمل ورأس المال ، ويمكنهما التنقل بحرية بين الصناعات ، ولكن ليس بين البلدان ؛
4) المقدار المحدود للعمالة ورأس المال في كل بلد ؛
5) الاختلاف الوحيد بين الدول هو اختلاف مخزون عوامل الإنتاج بنفس التقنيات ؛
6) لا توجد تكاليف النقل.
يتم تقديم مفاهيم كثافة العامل وتشبع العامل. كثافة العاملهو مؤشر يميز التكاليف النسبية المختلفة للعمالة ورأس المال عند الإنشاء البضائع الفردية... من هذه المواقف ، يتم تقسيم البضائع المنتجة إلى صناعة ثقيلةو تتطلب رؤوس أموال ضخمة. عامل التشبع (عامل التكرار)يقارن مخزونات العوامل بين البلدان. يمكن أن يكون البلد مشبعًا برأس المال (فائض رأس المال) أو مشبعًا بالعمالة (فائض العمالة).
بناء على ما تقدم نظرية هيكشر-أولينيمكن أن تصاغ على النحو التالي: مع تسعى البلدان إلى تصدير تلك السلع كثيفة العوامل التي تستخدم في إنتاجها موارد إنتاج فائضة نسبيًا ، واستيراد تلك السلع التي تتطلب إنتاجها موارد نادرة نسبيًا.
تنشأ الاختلافات الدولية في شكل منحنيات إمكانيات الإنتاج بشكل أساسي لأن إنتاج سلع مختلفة يتطلب عوامل إنتاج بنسب مختلفة ؛ والبلدان تختلف من حيث توافر عوامل الإنتاج. لذلك ، لا يتعين على بلد ما أن يتخصص بشكل كامل في إنتاج نوع واحد من المنتجات.
ملحق Samuelsonعلى النحو التالي: معادلة أسعار عوامل الإنتاج أمر لا مفر منه.لكن نظرية هيكشر-أولين-صامويلسونيعمل فقط في حالة وجود نفس التقنيات في جميع البلدان. فيما يتعلق بالعالم الحقيقي ، يمكن إعادة صياغته على النحو التالي: يجب أن تتسبب التجارة الحرة في ميل أسعار عوامل الإنتاج إلى التقارب إذا كانت التجارة بين البلدان تستند إلى الاختلافات في مواهب عوامل الإنتاج.
تم إجراء التحقق من نظرية Heckscher-Ohlin بواسطة V. رأس المال. باستخدام طريقة "المدخلات والمخرجات" ، قام V. Leontiev بحساب تكاليف العمالة ورأس المال لحزمة تمثيلية لصادرات الولايات المتحدة بقيمة 1 مليون دولار. أما بالنسبة للواردات ، فقد استخدم بيانات عن بدائل الاستيراد ، حيث لم يكن لديه معلومات عن واردات الولايات المتحدة الفعلية. بدائل الاستيراد هي السلع التي يتم إنتاجها في بلدها والمستوردة من الخارج. وكانت النتائج على النحو التالي: كانت واردات الولايات المتحدة أكثر كثافة في رأس المال بنحو 30٪ من الصادرات. وبالتالي ، صدّرت الولايات المتحدة في الغالب منتجات كثيفة العمالة واستوردت سلعًا كثيفة رأس المال. تم تسمية النتيجة مفارقة ليونتيف... ومع ذلك ، فهو لا يدحض نظرية هيكشر-أولين ، ولكنه يقوم فقط بتنقيحها. يمكن تفسير المفارقة نفسها على النحو التالي:
1) في التحليل ، من الضروري تقسيم عوامل الإنتاج إلى مجموعات فرعية ، منذ ذلك الحين أنها غير متجانسة (على سبيل المثال ، القوى العاملة - الماهرة وغير الماهرة) ؛
2) إلى أقصى حد ، تم تزويد الولايات المتحدة بالأراضي الزراعية والموظفين المؤهلين ، وبالتالي فإن حصة المنتجات الزراعية والسلع عالية التقنية في الصادرات الأمريكية كبيرة ، ويتم تمثيل الواردات بالسلع كثيفة العمالة التي تتطلب الاستخدام العمالة الرخيصة منخفضة المهارة (المنسوجات والأحذية) لتصنيعها ، وكذلك المواد الخام والمعادن من البلدان الغنية بالموارد ؛
3) من الضروري مراعاة تأثير سياسة التجارة الخارجية للدولة ، والتي يمكن أن تحفز تصدير منتجات تلك الصناعات حيث يتم استخدام عوامل الإنتاج النادرة نسبيًا بشكل مكثف ؛
4) يجب أن يؤخذ في الاعتبار وجود قابلية انعكاس عوامل الإنتاج: يمكن أن تكون سلعة ما في بلد فائض رأس المال كثيفة رأس المال ؛ في فائض العمالة - شاقة.
بشكل عام ، يمكن أن تُعزى أوجه القصور في النظرية الكلاسيكية الجديدة إلى حقيقة أنها لا تفسر سبب استمرار البلدان التي يتم تزويدها بشكل متساوٍ تقريبًا بعوامل الإنتاج في التجارة ؛ لا توجد إجابة على السؤال حول لماذا تأخذ التجارة المضادة في السلع المصنعة المماثلة حصة متزايدة في هيكل التجارة الدولية.
2.2.4. تطوير النظريات الكلاسيكية للتجارة الدولية.تم تطوير النظريات الكلاسيكية في اتجاهين رئيسيين: الأول شمل انتشارها في العديد من البلدان والسلع ، والثاني - ركز على إيجاد إجابات للأسئلة التي لم يتم أخذها في الاعتبار في النظريات الأساسية للتجارة الدولية. يتضمن المجال الأخير نظرية عوامل الإنتاج المحددة (P. Samuelson and R. Jones) ، نظرية Samuelson-Stolper (تأثير التغيرات في أسعار السلع الأساسية على الدخل من عوامل الإنتاج) ، نظرية Rybchinsky (تأثير العرض من عوامل الإنتاج على الدخل من الإنتاج ، "المرض الهولندي") ، تأثير جونز التضخمي. دعونا نتناولها بمزيد من التفصيل.
نظرية عوامل الإنتاج المحددةيجيب (P. Samuelson و R. خاصة بصناعة واحدة فقط. يتم النظر في دولتين وسلعتين وثلاثة عوامل إنتاج (العمالة ورأس المال والأرض). الأرض ورأس المال موارد محددة ، والعمل متنقل. بناء على هذا، نظرية Samuelson-Johnsonيبدو كالتالي: نتيجة للتجارة الدولية ، تتطور عوامل خاصة بقطاع التصدير ، بينما تقل العوامل الخاصة بالقطاع المنافس للواردات ؛ يتزايد دخل صاحب العوامل الخاصة بالصناعات التصديرية ، بينما يتناقص دخل أصحاب العوامل الخاصة بالصناعات التي تتنافس مع الواردات.
على المدى الطويل ، يمكن أن تنتقل العوامل بين القطاعات استجابة للتغيرات في الدخل. في هذه الحالة ، قد يبدو التقسيم بين الفائزين والخاسرين مختلفًا بعض الشيء.
نظرية Samuelson-Stolperيجيب على السؤال: كيف تتصرف أسعار عوامل الإنتاج عندما ترتفع أو تنخفض أسعار السلع التي تستخدم في إنتاجها.
تتم صياغة متطلبات النموذج على النحو التالي:
1) يتم إنتاج سلعتين ، إحداهما كثيفة العمالة ، والأخرى كثيفة رأس المال ؛
2) يمكن أن تنتقل عوامل الإنتاج بين القطاعات ، فهناك توظيف كامل في الدولة ، وإجمالي المعروض من عوامل الإنتاج لم يتغير ؛
ح) كلا الاقتصادين يعملان في ظروف المنافسة الحرة:
4) تعني تكنولوجيا الإنتاج وفورات الحجم الثابتة.
نظرية Samuelson-Stolperيبدو مثل هذا: تؤدي التجارة الدولية إلى زيادة دخل أصحاب العوامل التي يتم استخدامها بشكل مكثف لإنتاج سلعة يرتفع سعرها ، وانخفاض أسعار العوامل التي يتم استخدامها بشكل مكثف لإنتاج سلعة ، السعر الذي ينخفض. في هذه الحالة ، تحدث الزيادة أو النقصان في سعر العوامل إلى حد أكبر من الزيادة أو النقصان في سعر السلع.
إحدى النتائج المهمة لهذه النظرية هي أن الحركة نحو التجارة الحرة تؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي لعامل زائد نسبيًا ، وانخفاض - لعامل نادر نسبيًا. علاوة على ذلك ، يستفيد أصحاب العامل الزائد بغض النظر عن الصناعة التي يستخدم فيها هذا العامل. هذا لأنه عندما تتطور التجارة الحرة ، يرتفع سعر السلع المصدرة وينخفض سعر البضائع المستوردة. ارتفاع أسعار الصناعات التصديرية يحفز على التوسع في الإنتاج. في الصناعات التي تنافس الواردات ، يتراجع الإنتاج. على سبيل المثال ، صناعة التصدير كثيفة رأس المال. يؤدي الطلب المفرط على رأس المال إلى ارتفاع سعره ؛ يؤدي العرض المفرط للعمالة إلى انخفاض سعرها. ومع ذلك ، يعاني أصحاب رأس المال من زيادة في سعر رأس المال في كلا المجالين.
نظرية Rybczynskiيجيب على السؤال: ماذا سيحدث لدخل أصحاب العوامل إذا تغير العرض من أحد الموارد. تمت صياغته على النحو التالي: يؤدي العرض المتزايد لأحد العوامل إلى زيادة النسبة المئوية في الإنتاج وزيادة الدخل في الصناعة حيث يتم استخدام هذا العامل بشكل مكثف ، وإلى انخفاض في الإنتاج في القطاعات الأخرى.
أحد المظاهر الملموسة لنظرية Rybchinskiy هو ما يسمى بـ " المرض الهولندي". عندما تكون في السبعينيات. القرن العشرين بدأت هولندا في تطوير حقل للغاز الطبيعي في بحر الشمال ، ورافق الزيادة السريعة في إنتاج الغاز تدفق الموارد إلى الصناعة الاستخراجية من الصناعات التحويلية ، مما أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج فيها.
في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الستينيات والسبعينيات. القرن العشرين ولوحظ وضع مماثل: اكتشاف حقول نفط وغاز كبيرة في غرب سيبيريا ، وزيادة إنتاج الطاقة "وضع حدًا لإعادة بناء الهندسة المدنية المحلية ، الزراعةوغيرها من الصناعات "الضيقة".
2.2.5. نظريات بديلة للتجارة الخارجية.تدحض النظريات البديلة النظريات الكلاسيكية تمامًا وتقدم تفسيراتها الخاصة لأسباب التجارة الدولية وإمكانيات النجاح في السوق العالمية. في هذا القسم ، سننظر فقط في أشهر النظريات الحديثة.
0. فرضية تأخر المحاكاة(M. Posner، 1961) هو نوع من فرضية نظرية فيرنون ، والتي سيتم النظر فيها بعد ذلك. هناك تأخر في انتشار التكنولوجيا بين البلدان. يشمل تأخر التقليد فترة التدريب والتعريف (وقت الحصول على التكنولوجيا وبدء الإنتاج) ووقت شراء المواد والمعدات وإحضار المنتج إلى المشتري ، إلخ.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك تأخر في جانب الطلب ، والذي يتضمن الوقت اللازم لإدراك أن هناك بديلًا للمنتج المستهلك حاليًا (الولاء للمنتج ، ونقص المعلومات ، والقصور الذاتي ، وما إلى ذلك).
على سبيل المثال ، إذا كان تأخير المحاكاة هو 15 شهرًا ، وتأخر جانب الطلب 4 أشهر ، فسيكون صافي التأخر 11 شهرًا - حيث سيصدر بلد الابتكار المنتج.
وبالتالي ، لكي تكون ناجحًا في السوق العالمية ، من الضروري التركيز على تجارة المنتجات الجديدة ؛ لكي تكون مصدرًا ناجحًا ، من الضروري ابتكار منتجات جديدة باستمرار.
1. نظرية دورة حياة المنتج(ر.فرنون ، الستينيات من القرن العشرين). تمر دورة حياة المنتج بالمراحل التالية: المقدمة ، والنمو ، والنضج ، والانحدار.
تطبيقتتميز الشركة المصنعة بالإنتاج على نطاق صغير ، وتحتل مكانة احتكارية تقريبًا ، ويذهب جزء صغير من الإنتاج إلى السوق الخارجية.
نموتتميز ب: زيادة التوحيد القياسي ، وزيادة المنافسة ، والتوسع في الصادرات.
على المسرح نضج- الإنتاج على نطاق واسع ، وهيمنة عوامل السعر في الصراع التنافسي ، ولم يعد بلد الابتكار يتمتع بمزايا تنافسية ، ويبدأ الإنتاج في الانتقال إلى البلدان النامية بسعر رخيص القوى العاملة.
يتناقصيكمن في انخفاض الطلب ، لا سيما في البلدان المتقدمة ، وتركيز أسواق الإنتاج والمبيعات في البلدان النامية ، ويصبح بلد الابتكار مستورداً صافياً.
النظرية ليست عالمية ، على الرغم من أن تأكيدها يمكن العثور عليه في تطوير دورة حياة بعض المنتجات. على سبيل المثال ، تم اختراع التلفزيون في الولايات المتحدة ، ثم تم إنتاجه بكميات كبيرة في اليابان وأوروبا ، والآن انتقل إنتاجه إلى الدول الآسيوية. استنتاج النظرية هو أنه من أجل تحقيق النجاح في السوق العالمية ، يجب على الدولة تقديم منتجات جديدة باستمرار.
2. اقتصاديات نظرية المقياس(P. Krugman ، K. لانكستر ، الثمانينيات من القرن العشرين).
إن جوهر اقتصاديات حجم الإنتاج هو أنه مع وجود تقنية معينة وتنظيم الإنتاج ، ينخفض متوسط التكاليف على المدى الطويل مع زيادة حجم الإنتاج.
يتم تزويد العديد من البلدان بعوامل الإنتاج بنفس النسب ، وفي هذه الظروف يكون من المربح لها التجارة مع بعضها البعض مع التخصص في تلك الصناعات التي تتميز بتأثير وجود الإنتاج الضخم. وهكذا ، فإن التجارة الدولية تسمح بتكوين سوق واحد متكامل.
تتمثل عيوب النظرية في أنه أولاً ، يتم انتهاك المنافسة الكاملة ؛ ثانيًا ، تتركز التجارة الدولية في أيدي الشركات الدولية العملاقة - الشركات عبر الوطنية ، مما يؤدي إلى زيادة التجارة داخل الشركة ، والتي تحددها الأهداف الاستراتيجية للشركة نفسها ، وليس البلدان التجارية.
3. نظرية الميزة التنافسية(م.بورتر ، 1991).
في الظروف الحديثة ، لا يرتبط جزء كبير من تدفقات السلع في العالم بالمزايا الطبيعية ، ولكن بالمزايا المكتسبة ، التي تشكلت بشكل هادف في سياق المنافسة. في السوق العالمية ، تتنافس الشركات وليس البلدان. لكي تكون ناجحًا ، من الضروري الجمع بين الاستراتيجية التنافسية المختارة بشكل صحيح للشركة والمزايا التنافسية للبلد. تعتمد المزايا التنافسية الدولية للشركات الوطنية العاملة في الصناعات على البيئة الكلية لبلدهم ، والتي يتم تحديدها بأربعة محددات الميزة التنافسية... وتشمل هذه:
1) ظروف العوامل - توافر عوامل الإنتاج (علاوة على العوامل المتخصصة - المعرفة العلمية والتقنية ، قوة العمل المؤهلة تأهيلا عاليا ، إلخ) ؛
2) معايير الطلب المحلي على منتجات بلد معين - "الجودة" وحجم الطلب المحلي ، ودقة المستهلكين ؛
3) وجود الصناعات الموردة التنافسية والصناعات ذات الصلة التي تنتج منتجات تكميلية ؛
4) التنافس الداخلي - طبيعة المنافسة في السوق الداخلية ، الخصائص الوطنية للاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك ، يضيف م. بورتر إلى المحددات الأربعة الرئيسية وجود الصدفة والسياسة الهادفة للدولة.
تتمتع البلدان بأكبر فرص النجاح في تلك الصناعات التي يكون فيها "الماس" المحدد للميزة التنافسية هو الأكثر ملاءمة.
نظرًا لحقيقة أن البلدان المختلفة تتميز بمجموعة مختلفة من محددات المزايا التنافسية ، يحدد إم. بورتر المراحل التالية من دورة حياة الدولة:
1) مرحلة عوامل الإنتاج (تتنافس البلدان في المقام الأول من خلال استخدام المزايا التنافسية المرتبطة بعوامل الإنتاج ، والعمالة الأرخص ، والأراضي الأكثر خصوبة) ؛
2) مرحلة الاستثمار (تعتمد تنافسية الاقتصاد على النشاط الاستثماري للدولة والشركات الوطنية ، مع قدرة المنتجين الوطنيين على التكيف والتحسين. التقنيات الأجنبيةحاسمة للوصول إلى هذه المرحلة ، زيادة الاستثمار تؤدي إلى خلق عوامل جديدة متقدمة وتطوير البنية التحتية الحديثة) ؛
3) مرحلة الابتكارات (التي تتميز بوجود جميع العوامل الأربعة في مجموعة واسعة من الصناعات التي تتفاعل باستمرار ، ويزداد تنوع طلب المستهلك بسبب نمو الدخل الشخصي ، وزيادة مستوى التعليم و الرغبة في الراحة ، وكذلك بسبب تحفيز المنافسة الداخلية) ؛
4) مرحلة الثروة (انخفاض في الإنتاج ، القوة الدافعة للاقتصاد هي الوفرة التي تم تحقيقها بالفعل ، بدأت الدولة والشركات في الحصول على مراكز في المنافسة الدولية ، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام للاحتفاظ بالمناصب العامة ، تفضل الشركات غير النشطة الاستثمار ، لكن الاستراتيجيات المتحفظة القائمة على الدعم من السلطات).
لكل مرحلة ، يقترح م. بورتر أولويات نموذجية لسياسة الدولة الاقتصادية.
· مرحلة عوامل الإنتاج: خلق الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي والمحافظة عليهما وتحقيق سيادة القانون ، وتحقيق مستوى عالٍ من البنية التحتية المادية والتعليم العام ، وفتح الأسواق ، وخلق الظروف لاستيعاب (اقتراض) التقنيات ذات المستوى العالمي وجذبها. الاستثمار الأجنبي المباشر.
· مرحلة الاستثمار: الاستثمار في تحسين البنية التحتية المادية ومرافق البحث والتطوير ، وتعزيز تنمية التجمعات ، وخلق القدرات للبقاء في صدارة التقنيات الأجنبية وتوسيع القدرات على طول سلسلة القيمة بأكملها ، أي من الصناعات الاستخراجية إلى الصناعات التحويلية.
· مرحلة الابتكار: زيادة تعزيز تطوير التجمعات ، وخلق موارد بحثية عالمية المستوى ، وخلق الظروف للشركات الوطنية لتطوير استراتيجيات فريدة وأفضل الابتكارات في العالم.
4. نظرية الطلب المتداخل(S. Linder ، 60s من القرن العشرين).
المستهلكون في البلدان التي لديها نفس الدخل تقريبًا لديهم أذواق متشابهة تقريبًا. سيتم تصدير المنتج إلى تلك البلدان التي يكون فيها هيكل الطلب مشابهًا ، أو على الأقل يمكن مقارنته بالطلب المحلي للبلد المصدر. النظرية محدودة لأن في معظم البلدان ، الفجوة في مستويات الدخل لشرائح مختلفة من السكان كبيرة للغاية.
الاستنتاج العام للنظرية هو أن البلدان التي لديها نفس دخل الفرد تقريبًا سوف تتاجر بشكل مكثف فيما بينها. علاوة على ذلك ، عند الحديث عن التجارة ، لا يتم تحديد الصادرات أو الواردات. في السؤال... يقول S. Linder أن كلاً من الصادرات والواردات (أي التجارة داخل الصناعة) ستكون مكثفة.
5. نظرية التجارة داخل الصناعة.
تحدث التجارة داخل الصناعة عندما يصدر بلد ما ويستورد منتجات من مجموعة منتجات واحدة. النظريات التقليدية تنظر فقط في التجارة بين الصناعات.
تشمل أسباب التجارة البينية ما يلي:
1) الاختلافات في المنتجات المصنعة ( سلع مختلفةضمن مجموعة واحدة ، على سبيل المثال ، السيارات) ؛
2) تكاليف النقل والموقع الجغرافي (في المناطق الحدودية يكون الشراء في الخارج أكثر ربحية منه في مناطق أخرى من البلاد ، لأنه أرخص) ؛
3) ديناميات اقتصاديات حجم الإنتاج (انخفاض تكاليف الإنتاج لمنتج معين ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجه ، وينشأ نوع من التخصص) ؛
4) درجة التجميع في المعالجة الإحصائية للبيانات (كلما تضمنت فئة السلع ، زادت أهمية التجارة داخل الصناعة) ؛
5) المفاضلة في توزيع الدخل داخل الدولة.
كلما ارتفع مستوى الدخل في بلد ما ، زادت التجارة داخل الصناعة. كلما كان البلد أكثر تطوراً ، زاد التمايز بين المنتجات ، وزادت إمكانية تحقيق وفورات الحجم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤشرات التالية لها علاقة إيجابية بدرجة التجارة البينية: مستوى دخل الفرد ، الناتج المحلي الإجمالي ، درجة انفتاح الاقتصاد ، ووجود حدود مشتركة بين الدول.
 أصغر وأنجح رجال الأعمال في العالم
أصغر وأنجح رجال الأعمال في العالم مهن واعدة جديدة: من سيكون في القرن الحادي والعشرين المهن التي ظهرت في القرن الحادي والعشرين
مهن واعدة جديدة: من سيكون في القرن الحادي والعشرين المهن التي ظهرت في القرن الحادي والعشرين غارقة في السعادة. بوريس باسترناك. في دخان الرغبات المكبوتة سوف ينجذب الناس إليك
غارقة في السعادة. بوريس باسترناك. في دخان الرغبات المكبوتة سوف ينجذب الناس إليك كم عدد الطيور في الصورة. Class Birds (Aves). الهيكل الخارجي للطيور
كم عدد الطيور في الصورة. Class Birds (Aves). الهيكل الخارجي للطيور كيفية تنمية صفات الشخصية الناجحة
كيفية تنمية صفات الشخصية الناجحة كيف تقرر أن تبدأ عملك الخاص
كيف تقرر أن تبدأ عملك الخاص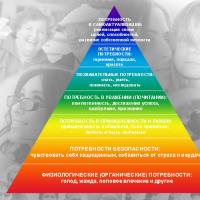 كيف تقرر أن تبدأ عملك الخاص
كيف تقرر أن تبدأ عملك الخاص